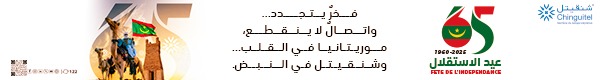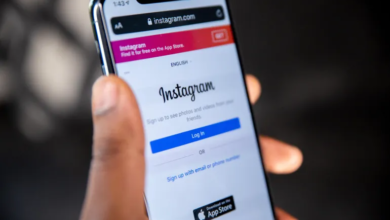صواريخ “تتراقص” خارج نطاق الرؤية: كيف كسرت إيران معادلات الدفاع الجوي في تل أبيب؟

في ليلة السادس عشر من يونيو/حزيران 2025، لم تكن سماء تل أبيب شاهدة على مواجهة تقليدية، بل على عرض تقني فريد أشبه برقصة صامتة مميتة. فقد أطلقت إيران صواريخ فرط صوتية عالية المناورة، لا تصدر هديرًا ولا تظهر بمسارات يمكن التنبؤ بها، بل تنساب عبر طبقات الغلاف الجوي بسرعة تتجاوز الإدراك، متجنبة بدقة أنظمة الدفاع الأكثر تطورًا، وعلى رأسها منظومة “ثاد” الأميركية.
تبدو هذه الصواريخ كما لو أنها تدرك قواعد الاشتباك التقليدية لتتجاوزها عمدًا، إذ لا تسير بخط مستقيم، ولا تلتزم بمسار أو ارتفاع ثابت. بل تتحول رؤوسها الحربية إلى أجسام انزلاقية قادرة على تغيير الاتجاه والسرعة والارتفاع بشكل لحظي، مما يجعل اعتراضها تحديًا لا يواجه السرعة وحدها، بل الذكاء أيضًا.
الرقص في “المنطقة الرمادية”
أحد أسرار فعالية هذه الصواريخ هو قدرتها على التحليق في ارتفاعات تراوغ رادارات الدفاع الجوي، وتحديدًا بين 30 و50 كيلومترًا، وهي منطقة تُعرف عسكريًا بـ”تحت أفق الكشف”. فرادار AN/TPY-2 الخاص بمنظومة “ثاد” مصمم أساسًا لرصد الأهداف القادمة من أعلى، لا تلك التي تنزلق أفقيًا على الأطراف. وهكذا، وجدت الصواريخ الإيرانية لنفسها “منطقة عمياء” تؤدي فيها مناوراتها دون أن تُرصد.
المناورة داخل متاهة الخوارزميات
حتى عندما ترصد الرادارات الهدف، تبدأ المرحلة الأصعب: التنبؤ بمساره. الصواريخ الإيرانية لم تتبع خطًا مستقيمًا، بل راوغت كما لو أنها تدرك كيف تفكر خوارزميات الدفاع. فبين كل نبضة رادارية، كانت تغير اتجاهها وارتفاعها، مما أربك أنظمة التتبع مثل “Kalman Filter” التي تُستخدم لتقدير موقع وسرعة الهدف بناء على بيانات مستمرة.
ومع تعدد الاحتمالات، كما في خوارزمية “Multi-Hypothesis Tracking”، تجد أنظمة الدفاع نفسها تطارد أكثر من شبح في وقت واحد، دون أن تدرك أيها الهدف الحقيقي.
عندما تصبح السرعة خصمًا للزمن
عند سرعة تتجاوز ماخ 13 (أكثر من 4 كم/ثانية)، تصبح نافذة القرار قصيرة للغاية. فأنظمة مثل “Track-While-Scan” المصممة لتتبع أهداف متعددة، تجد نفسها أمام كم هائل من البيانات المتغيرة، وتُجبر على اتخاذ قرارات في زمن أقصر من قدرتها على الحساب. وهنا، لا يكون الفشل ناتجًا عن عطل ميكانيكي، بل عن “شلل رقمي” يصيب الخوارزميات.
وقد أشار تقرير لمكتب تقييم الأداء في وزارة الدفاع الأميركية (DOT&E) عام 2023 إلى هذا التحدي، مؤكدًا أن الصواريخ الفرط صوتية “تتجاوز القدرات الزمنية الحالية لأجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية”.
الرقص بين طبقات الدفاع
تعتمد العقيدة الدفاعية الأميركية على أنظمة متداخلة: مثل SM-3 للاعتراض من الفضاء، و”ثاد” للطبقة المتوسطة، و”باتريوت” للدفاع القريب. لكن بين هذه الطبقات، توجد فجوات تشغيلية تُعرف باسم “defense layer seams”، حيث لا يكون واضحًا من يتولى الرصد أو الاعتراض في اللحظة الحرجةالصواريخ الإيرانية صُممت تحديدًا لتضرب داخل هذه الفجوات، فتتجنب الارتفاع العالي كي لا تلتقطها SM-3، ولا تهبط مبكرًا كي لا تعالجها “باتريوت”، بل تبقى في “المنطقة الرمادية” التي تُربك توزيع المهام الدفاعية.
سحابة التشويش: الضوضاء التي تعمّي القرار
ما يزيد التعقيد هو تكتيك “الإغراق الدفاعي”، حيث يتم إطلاق موجة من الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والشراك الإلكترونية دفعة واحدة، ما يربك الرادارات ويُرهق مراكز القرار. ووفق دراسة لمؤسسة RAND (2022)، فإن هذا النوع من الهجوم لا يستهدف فقط الرادار، بل يعطّل أيضًا حلقات اتخاذ القرار البشرية والخوارزمية.
صاروخ… يفكّر بمفرده
التطور الأبرز في هذه الصواريخ يتمثل في استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة التوجيه، ما يمنح الرأس الحربي القدرة على اتخاذ قرارات لحظية بناءً على ما “يراه” في السماء. فبدل أن يكون مبرمجًا مسبقًا، يتحول إلى كيان شبه مستقل يغير مساره تبعًا للمعطيات اللحظية.
وتشير تقارير – من بينها دراسة لمؤسسة RAND – إلى أن إيران، إلى جانب الصين، تطور مثل هذه القدرات التي تُنقل الصاروخ من مجرد مقذوف إلى “مناور ذاتي” يُجيد اللعب خارج قوانين الاشتباك التقليدي.
خطر مركّب يتجاوز الصواريخ ذاتها
ما يجعل هذه الصواريخ تهديدًا نوعيًا ليس عنصرًا واحدًا، بل اجتماع خمس طبقات معقدة من القوة:
- سرعة خارقة تفوق 13 ماخ
- مناورات آنية لا يمكن التنبؤ بها
- تحليق في ارتفاعات تتجاوز نطاق الرادارات التقليدية
- تشويش إلكتروني يربك أنظمة الاستشعار
- ذكاء اصطناعي داخل الرأس الحربي يتخذ قرارات لحظية
كل طبقة من هذه الطبقات كفيلة بإرباك منظومة مثل “ثاد”، لكن اجتماعها يُحول كل محاولة اعتراض إلى ما يشبه “مطاردة راقص محترف يختار موسيقاه الخاصة”.
الخاتمة: عندما تتأخر الخوارزمية عن زمن المعركة
لم يعد السؤال في المعارك الحديثة: “هل تستطيع المنظومة إسقاط الصاروخ؟”، بل: “هل تدرك المنظومة أصلًا ما الذي تواجهه؟”.
فالتحدي الأكبر لم يعد في الصاروخ الذي ينطلق، بل في اللحظة التي تُصبح فيها الخوارزمية أبطأ من قرار الرؤوس الحربية الذكية.