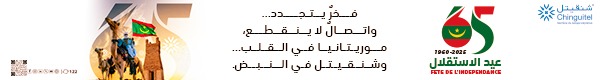بين الجرح والهوية: نحو مقاربة هادئة للجدل الهوياتي في موريتانيا

بقلم: حمادي سيدي محمد آباتي
يشير المفكر المغربي حسن أوريد إلى أن المرحلة الراهنة تشهد ما يسميه بـ”الهوس الهوياتي”، أي انتقال الهوية من كونها إطاراً ثقافياً غنياً ومتعدداً إلى عقيدة مغلقة تُستعمل لتحديد من ينتمي ومن يُقصى. في هذا السياق، يتقدم سؤال “من نحن؟” على سؤال “كيف نعيش معاً؟”، وتتحول اللغة والتاريخ والذاكرة إلى ساحات صراع رمزي.
هذا التشخيص، وإن وُلد في سياق أوسع، يجد صداه في الجدل الدائر داخل موريتانيا حول الهوية، خاصة في النقاش المتعلق بموقع لحراطين داخل البنية الاجتماعية والثقافية الوطنية. غير أن تنزيل هذا المفهوم على الحالة الموريتانية يقتضي حذراً وتوازناً، حتى لا يتحول التحليل ذاته إلى جزء من الاستقطاب الذي يسعى إلى تفكيكه.
الهوية بين البنية الثقافية والتجربة الاجتماعية
تشكل المجتمع الموريتاني عبر مسارات تاريخية معقدة، تداخلت فيها الهجرات، والتحالفات، والأنظمة الاقتصادية التقليدية، ومن بينها نظام الرق الذي مثّل ظلماً اجتماعياً عميقاً طال فئات واسعة من الناس. وقد عرفت مناطق متعددة في غرب إفريقيا أنماطاً من الاسترقاق ضمن سياقات سياسية واقتصادية مختلفة، بما في ذلك فضاءات تاريخية مثل إمبراطورية غانا وإمبراطورية سونغاي.
غير أن استحضار هذا الامتداد التاريخي لا ينبغي أن يتحول إلى آلية تبرير أو تبسيط. فالظلم، أياً كان مصدره، يظل ظلماً، وتجربته تترك أثراً عميقاً في الوعي الجمعي. وهنا تبرز نقطة محورية: هل الظلم التاريخي يُنتج هوية مستقلة؟ أم أنه يُنتج وعياً اجتماعياً خاصاً داخل هوية أوسع؟
التمييز بين الأمرين ضروري. فالهوية، في معناها الثقافي، تقوم على عناصر مثل اللغة، والرموز، والسردية التاريخية المشتركة. أما التجربة الاجتماعية الخاصة، حتى وإن كانت مؤلمة وممتدة زمنياً، فقد تخلق وعياً مطلبياً أو احتجاجياً، لكنها لا تعني بالضرورة نشوء هوية إثنية منفصلة.
من الذاكرة إلى المواجهة الرمزية
تتعقد المسألة حين تتحول الذاكرة إلى محكمة دائمة، ويُقرأ الحاضر بمنطق المظلومية المستمرة، وتُختزل الهوية في عنصر واحد يُدافع عنه بمنطق المواجهة. في هذه اللحظة، يصبح النقاش حول الانتماء مشحوناً، ويتراجع سؤال المواطنة الجامعة لصالح تصنيفات حادة.
لكن في المقابل، فإن إنكار الجرح أو التقليل من أثره لا يقل خطورة. فالمجتمعات التي لا تعترف بماضيها تجد نفسها تعيد إنتاجه بصور مختلفة. ومن ثم فإن أي مقاربة متوازنة يجب أن تنطلق من الاعتراف الصريح بظلم الاسترقاق تاريخياً، دون أن يتحول هذا الاعتراف إلى مدخل لتفكيك الإطار الوطني المشترك.
الهوية كمسار لا كجوهر ثابت
من المفيد النظر إلى الهوية بوصفها مساراً تاريخياً متطوراً، لا جوهراً ثابتاً نقياً. فالمجتمعات لا تتشكل من كتل صافية، بل من تفاعلات وتداخلات طويلة. والبحث عن “نقاء هوياتي” غالباً ما يكون استجابة لقلق جماعي أكثر منه تعبيراً عن حقيقة تاريخية.
في الحالة الموريتانية، تتشارك المكونات الاجتماعية اللغة والدين والفضاء الثقافي العام، رغم اختلاف التجارب الاجتماعية. هذا الاشتراك لا ينفي الخصوصيات، لكنه يشير إلى أن الإطار الأوسع ما يزال قائماً.
ومن هنا، فإن تحويل الجدل من سؤال “هل نحن هوية مستقلة؟” إلى سؤال “كيف نضمن العدالة والكرامة داخل هوية وطنية جامعة؟” قد يكون أكثر نجاعة وأقل كلفة رمزية.
نحو مواطنة تتجاوز الاستقطاب
المخرج لا يكمن في إلغاء الهوية، ولا في تضخيمها إلى مستوى العقيدة السياسية المغلقة، بل في تحريرها من القلق. وهذا يمر عبر:
- الاعتراف التاريخي الواضح بالمظالم.
- الفصل بين نقد نظام اجتماعي تقليدي وبين نزع الشرعية الثقافية عن مجموعات كاملة.
- جعل المواطنة إطاراً أعلى وأفقاً جامعاً يسمو على كل الانتماءات الفرعية.
- تحويل الذاكرة من أداة إدانة إلى مسار مصالحة وإصلاح.
إن قوة المجتمعات لا تُقاس بغياب الاختلاف، بل بقدرتها على إدارة اختلافاتها ضمن عقد مدني عادل. وحين تتقدم المواطنة على العصبيات، تصبح الهوية فضاءً للتعايش لا سلاحاً رمزياً.
في نهاية المطاف، يبقى التحدي الحقيقي أمام موريتانيا اليوم ليس في حسم سؤال “من الأصيل ومن الطارئ”، بل في بناء إطار وطني يُشعر كل فرد بأن كرامته مصونة، وأن انتماءه لا يحتاج إلى صراع لإثباته. فالهويات تزدهر حين تشعر بالأمان، وتتحول إلى خنادق حين يسكنها الخوف.