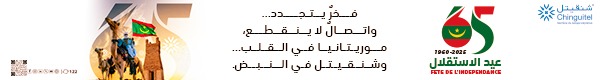حين ينهزم الحلم

في هذا البلد، لا تُهزم الأحلام دفعة واحدة،
إنها تُستنزف ببطء، باسم الحكمة أحيانًا، وباسم “مراعاة التوازنات” غالبًا،
حتى تستيقظ ذات يوم لتكتشف أن الحلم لم يُقتل، بل أُقصي بأدب.
في قطاع التربية، حيث يفترض أن تكون الكفاءة هي اللغة الوحيدة المفهومة، تتكرر مفارقة صامتة: من يشتغل في الهامش الجغرافي يُطالب بمعجزات، ومن يتموضع قرب المركز تُكفيه العلاقات. في الأطراف، تُقاس الجهود بعدد الأقسام التي اشتغلت رغم النقص، وبالبرامج التي نُفذت رغم ضعف الوسائل. وفي المركز، تُقاس الأمور بميزان آخر، لا تظهر أرقامه في التقارير.
هناك من اختار أن يكون مفتشًا بالمعنى القديم للكلمة: حضورٌ دائم، توجيهٌ صارم، وانحياز واضح للمدرسة العمومية باعتبارها العمود الفقري لما تبقى من فكرة الدولة. اشتغل في مقاطعة حدودية، حيث لا تغطي الشبكات إلا بالكاد، لكن تغطيها الإرادة. صنع مع طواقمه نتائج جعلت الأرقام تتكلم، لا في خطاب موسمي، بل في تقييم وطني شامل شهد له الجميع، حتى من لا مصلحة لهم في الشهادة.
في لحظة كهذه، يولد الأمل طبيعيًا:
أمل أن تكون الجمهورية قد تذكرت أحد أبنائها.
أمل أن يكون الإصلاح أكثر من لافتة تُرفع ثم تُطوى.
لكن الأمل في موريتانيا غالبًا ما يُستدعى ليُربَّت على كتفه ثم يُطلب منه الانتظار، لأن “المرحلة حساسة”، و”التوازنات دقيقة”، و”القرار لا يُتخذ تقنيًا فقط”.
وهنا تبدأ الأسئلة المؤلمة.
أيّ توازنات تلك التي تجعل الكفاءة عنصرًا مزعجًا؟
وأيّ حساسية تُبرر القفز على الاستحقاق؟
وكيف يُطلب من المدرسة العمومية أن تُصلح نفسها، بينما يُكافأ من يفرغها من الداخل، عبر تسويات مع التعليم الخصوصي، تُسجَّل فيها الأسماء هنا، وتُدفع الرسوم هناك، وتُسلَّم النتائج في صمتٍ مُريب؟
في هذا المناخ، يصبح الالتزام عبئًا، ويصير الإصرار على القانون نوعًا من السذاجة المهنية. من يرفض “التكيّف” يُوصَف بغير المرن، ومن يساير يُقدَّم بوصفه واقعيًا. وهكذا، لا يُقصى النزيه لأنه فاشل، بل لأنه لم يتعلم بعدُ كيف يخفف من ثقله الأخلاقي.
الخذلان هنا ليس شخصيًا، بل بنيويًا.
خذلان فكرة أن الوطن يتسع لأبنائه دون وساطة.
خذلان الإيمان بأن الخدمة في الهامش قد تُكافأ يومًا، لا أن تُنسى.
ثم يأتي العذر الجاهز، المصقول بعناية:
مراعاة التوازنات.
لكن، متى أصبحت التوازنات نقيضًا للكفاءة؟
ومتى تحوّل الحرص على الاستقرار إلى عقوبة للجدّية؟
وهل يُبنى قطاع حيوي كالتعليم على طمأنة الجميع، أم على إنصاف من يستحق؟
الخاتمة في مثل هذه القصة لا تكون مريحة.
لأن الوجع الحقيقي ليس في ضياع منصب، بل في الرسالة التي تُبعث دون كلام:
أن لا أحد يُخطئ إن خذل الحلم،
وأن النزاهة لا تزال فضيلة شخصية، لا معيارًا عموميًا.
وحين ينهزم الحلم في التربية،
لا يخسر مفتشٌ كفؤ فقط،
بل تخسر المدرسة روحها،
وتخسر الجمهورية شاهدًا كان يمكن أن يُثبت أن الإصلاح، في هذا البلد، ليس مستحيلًا… فقط غير مرغوب فيه أحيانًا.
حمادي سيدي محمد آباتي