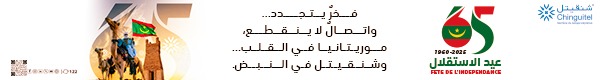مخبر الشرطة الجنائي: السيادة بين الضرورة وسوء التأسيس

ليس ثمة خلاف حول أن إنشاء مخبر جنائي وطني يُعدّ ضرورة سيادية مُلحّة، في بلد ظلّ، منذ الاستقلال، يرسل أدلة الجرائم وخبراتها إلى الخارج، خاصة فرنسا والسنغال. غير أن الاتفاق على أهمية الهدف لا يُعفي من مساءلة الطريقة التي وُلد بها المشروع، ولا السردية التي رافقته، ولا ما انكشف لاحقًا من وقائع تُحوِّل السؤال من “هل نحتاج مخبرًا؟” إلى “كيف تُتخذ القرارات السيادية؟”.
سردية التأسيس: من الدولة إلى المقهى
وفق الرواية التي قدّمها صحفي ورد اسمه ضمن المشمولين في ملف المخبر، فإن فكرة إنشاء هذا المرفق السيادي انبثقت من جلسة عابرة في مقهى بداكار، جمعته بشاب تحدّث عن شركة تركية متخصصة في تجهيز المخابر الجنائية. وعندما عاد الصحفي إلى نواكشوط، نقل الفكرة إلى وزير الداخلية، فنالت إعجابه، ليُتخذ القرار بإنشاء المخبر.
هذه السردية، في ظاهرها بسيطة، لكنها في عمقها مُقلقة؛ إذ كيف يُعقل أن يولد مشروع سيادي بهذه الحساسية من صدفة شخصية، خارج أي دراسة تقنية، أو تقييم للحاجة، أو نقاش داخل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة؟ وأين هي الإدارات الفنية، ومساطر الصفقات العمومية، ومنطق التخطيط الذي يُفترض أن يحكم القرارات الكبرى؟
اختلال الأدوار: حين يتحول الصحفي إلى وسيط
الأكثر إرباكًا من فكرة الصدفة ذاتها هو الدور الذي مُنح للصحفي، إذ تحوّل من ناقل معلومة إلى وسيط فعلي بين وزارة سيادة وشركة أجنبية. وهو دور لا يستند إلى صفة قانونية، ولا إلى اختصاص مهني، ولا إلى تفويض مؤسسي.
في الدول التي تُدار بالقانون، يُعدّ وجود وسيط غير رسمي في صفقات سيادية مؤشرًا خطيرًا، لا تفصيلًا ثانويًا. فالمبادرات الفردية، مهما حُسنت نواياها، لا يمكن أن تحل محل القنوات القانونية، لأن الدولة لا تُدار بالإعجاب الشخصي، بل بالمساطر والضوابط.
من حاجة وطنية إلى مشروع قابل للاستغلال
لا جدال في أن المخبر الجنائي حاجة حقيقية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل انطلق التفكير فيه من تشخيص مؤسسي للحاجة، أم جرى البحث عن مشروع مربح، ثم جرى لاحقًا تبرير ضرورته؟
الفرق بين الحالتين جوهري؛ ففي الأولى نحن أمام دولة تُخطط، وفي الثانية أمام شبكات تبحث عن فرص داخل مؤسسات الدولة، مستفيدة من غياب الشفافية وضعف الرقابة.
المال ككاشف لا يقبل التأويل
عندما كشفت منظمة الشفافية عن وجود رشاوى تُقدَّر بنحو مليونين ونصف يورو، استحوذ مدير الأمن ووزير الداخلية على النصيب الأكبر منها، فيما نال وزير سابق نصف مليون دولار، وتقاسم الصحفي وشخص آخر نحو ثلاثمائة ألف دولار لكل واحد، فإن سردية “الفكرة البريئة” تفقد أي معنى.
فالمال هنا لا يُستخدم كقرينة فحسب، بل ككاشف حاسم: إذ يصعب الجمع بين رواية المبادرة الوطنية ووقائع تقاسم المنافع. وما كان يُقدَّم بوصفه اجتهادًا يتحول، في ضوء هذه المعطيات، إلى شبهة استغلال لمشروع سيادي.
تطبيع خطير مع العبث المؤسسي
الأخطر من الفساد ذاته هو محاولة تطبيعه لغويًا وأخلاقيًا، عبر تحويل الرشوة إلى “عمولة”، والوسيط إلى “صاحب فكرة”، والقرار السيادي إلى نتيجة إعجاب عابر. هذا الخطاب لا يُضلل الرأي العام فحسب، بل يُفرغه من قدرته على المساءلة، ويُحوّل العبث إلى ممارسة عادية.
خاتمة: إعادة النقاش إلى مساره الصحيح
إن ملف المخبر الجنائي لا ينبغي أن يتحول إلى ساحة لتبادل التخوين أو تصفية الحسابات السياسية، لأن هذا المسار لا يخدم الحقيقة ولا يحمي الدولة. فالتخوين، حين يُستعمل بدل الحجة، يصبح وسيلة للهروب من الأسئلة الجوهرية، لا أداة للدفاع عن المصلحة العامة.
من الزاوية القانونية البحتة، لا يُمكن تحصين أي مشروع سيادي من المساءلة لمجرد رفع شعار الضرورة أو السيادة. فالقانون لا يُجرّم النوايا، بل يُحاسب على المساطر: كيف اتُّخذ القرار؟ هل احترمت قواعد الصفقات العمومية؟ هل وُجد تضارب مصالح؟ وهل تدخل وسطاء خارج الإطار القانوني؟ هذه الأسئلة ليست عداءً للدولة، بل هي جوهر دولة القانون.
وعليه، فإن النقاش السليم لا يجب أن يُختزل في الدفاع عن أشخاص أو مهاجمة آخرين، بل في تقييم نمط اتخاذ القرار نفسه. فالدولة القوية لا تخشى الأسئلة، بل تضعها في صلب إصلاحها، وتُميّز بوضوح بين الحاجة المشروعة إلى مشروع سيادي، وبين الطريقة التي قد تُحوّله إلى مدخل للفساد.
بهذا المعنى، فإن إعادة النقاش إلى جوهره ليست تشكيكًا في الدولة، بل دفاعًا عنها؛ لأن السيادة الحقيقية لا تُدار بمنطق الصدفة، ولا تُحمى بالتخوين، وإنما تُصان بالقانون والمؤسسات.
حمادي سيدي محمد آباتي