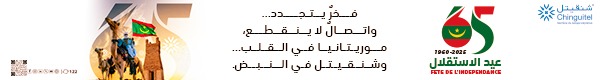ضربة فوردو.. أول اختبار قتالي لـ”جي بي يو-57″ يكشف حدود القوة الأميركية

فجر 22 يونيو/حزيران 2025، نفذت القاذفات الشبحية الأميركية من طراز بي-2 سبيريت هجوما مباشرا على منشأة فوردو النووية الإيرانية باستخدام القنبلة الخارقة للتحصينات جي بي يو-57، في أول استخدام قتالي لهذا السلاح بعد سنوات من التجارب.
ورغم ضخامة القنبلة التي يناهز وزنها 13 ألف كيلوغرام، فإن التحصينات العميقة داخل الجبل الكلسي بدت أكثر صلابة مما توقعته واشنطن، مما فتح بابا واسعا للجدل حول نجاح الضربة وحقيقة ما أصاب البرنامج النووي الإيراني.
التقديرات الأميركية الأولية، التي كشفت عنها تقارير استخباراتية، لم تتطابق مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث بأن المنشآت قد “دُمّرت بالكامل”. فوفق تقييم “وكالة الاستخبارات الدفاعية” (DIA)، أحدثت الضربة ضررا بالغا لكنه لم يصل إلى حد القضاء على المشروع، بل أدى فقط إلى تأخيره عدة أشهر.
كما أبلغت إدارة ترامب مجلس الأمن الدولي لاحقا أن الضربة “أضعفت” البرنامج النووي الإيراني، وهي صياغة أقل حدة من التصريحات الأولى. هذا التباين كشف حجم الشكوك داخل المؤسسة الأمنية الأميركية بشأن قدرة القنبلة على بلوغ أعماق المنشأة المدفونة، خاصة في ظل التكتم الإيراني على حجم الأضرار الفعلية.
اختبار أول يفتح باب الشكوك
بالتزامن مع انتشار صور الفوهات العميقة في فوردو ونطنز، أعادت وسائل إعلام أميركية ودولية الحديث عن برنامج أميركي جديد هو “المخترِق من الجيل التالي” (NGP)، والذي يُعد خليفة محتملا لـ”جي بي يو-57″. وقد جاء تداول المعلومات حول البرنامج وكأنه اعتراف ضمني بأن السلاح المستخدم لم يحقق “النتيجة الحاسمة” التي كان يُعوَّل عليها.
وأشارت التقارير إلى أن عملية الوصول إلى نقطة واحدة داخل فوردو تطلبت ست ضربات متتالية في الإحداثيات نفسها. إذ قامت القنابل الأولى بإزالة الطبقات العليا من الصخور والخرسانة، بينما واصلت القنابل اللاحقة التعمق تدريجيا حتى الوصول إلى الجزء المستهدف من المنشأة. هذا النهج عزز القناعة بأن مواجهة منشآت مدفونة بعشرات الأمتار داخل الجبال تتطلب تطوير سلاح أكثر خفة ومرونة وقدرة على اختراق أعماق أكبر دون اللجوء إلى هذا العدد من الذخائر.
نشأة القنابل الخارقة للتحصينات
تعود جذور هذه القنابل إلى حرب الخليج 1991، عندما احتاجت الولايات المتحدة إلى سلاح قادر على استهداف الملاجئ العراقية تحت الأرض. فظهرت حينها قنبلة جي بي يو-28 بوزن 2.3 طن. ثم تلتها نماذج أكثر دقة خلال التسعينيات مثل جي بي يو-37.
أما على المستوى النووي، فطوّرت الولايات المتحدة القنبلة بي 61-11، أول قنبلة نووية مخصصة للاختراق الأرضي، بقوة تصل إلى 400 كيلوطن. وقد عُدّلت لتنفجر تحت السطح مباشرة، ما يضاعف تأثيرها التدميري. ومع ذلك، ظلّ السلاح النووي محاطا بالاعتراضات، خصوصا مخاطر التسرب الإشعاعي، لينتهي المسار النووي العميق عام 2005.
بعد ذلك، تحوّل الجهد الأميركي نحو تطوير ذخائر تقليدية فائقة الثقل، لتظهر القنبلة جي بي يو-57، التي سُلّم عقد تطويرها لشركة بوينغ عام 2007. وهكذا أصبح لدى البنتاغون خياران: سلاح تقليدي خارق شديد القوة، وآخر نووي تكتيكي للسيناريوهات القصوى.
كيف تعمل القنابل الخارقة للتحصينات؟
عند إسقاط القنبلة، تبدأ عملية دقيقة لضبط المسار باستخدام منظومة مزدوجة تضم القصور الذاتي (INS) وتحديد الموقع العالمي (GPS)، لضمان الوصول إلى نقطة محددة تحت الأرض.
ويتيح الهيكل الفولاذي شديد الصلابة للقنبلة تحمّل صدمة الارتطام الهائل والاستمرار في التقدم داخل الصخور قبل الانفجار.
ويُفعَّل صاعق ذكي يقوم بتأخير الانفجار لأجزاء من الثانية، لتعميق الاختراق قبل التفجير. وتولّد موجة الضغط الزلزالية الناتجة عن الانفجار الجوفي تدميرا مضاعفا مقارنة بالانفجار على السطح.
وتستطيع “جي بي يو-57” اختراق نحو 18 مترا من الخرسانة المسلحة أو 60 مترا من التربة المضغوطة أو الحجر الجيري. ومع ذلك، فإن منشآت مدفونة على أعماق تتجاوز 80 مترا قد تصمد جزئيا أمام ضربة واحدة، ما يفسر لجوء الجيش الأميركي إلى ضربات متكررة على الإحداثيات نفسها.
ماذا عن القنبلة الجديدة؟
القنبلة الجديدة التي تعمل عليها الولايات المتحدة يفترض ألا يتجاوز وزنها 10 أطنان، أي أخف بنسبة 25% من وزن “جي بي يو-57”. هذا التخفيض يسهل دمجها مع القاذفة الشبحية الجديدة بي-21 رايدر، التي لا تستطيع حمل القنابل العملاقة الحالية.
وتدرس واشنطن تزويدها بمحرك صاروخي يمنحها قدرة أكبر على الاختراق وإمكانية الإطلاق من مسافات آمنة، ما يقلل من تهديد الدفاعات الجوية المعادية. وهذا يمثل انتقالا من مفهوم “القوة الضخمة” إلى “القوة الذكية”، القائمة على الدقة والتصميم والتقنيات الملاحية المتطورة.
وتشير شركة “الأبحاث التطبيقية” (ARA) إلى أن السلاح الجديد لن يكون مجرد نسخة مخففة، بل منظومة جديدة قادرة على التعامل مع صخور صلبة بعمق يصل إلى مئات الأمتار.
كما تشارك شركة بوينغ في تطوير “ذيل التوجيه”، القادر على العمل حتى في بيئات تُعطَّل فيها إشارات GPS، وهو تطور مهم للتعامل مع دول تملك قدرات تشويش متقدمة مثل الصين وروسيا.
العمق الجيولوجي كسلاح دفاعي
تأتي هذه الجهود الأميركية في ظل إدراك متزايد بأن خصومها بنوا دفاعاتهم تحت الأرض. فإيران تعتمد على الجبال لحماية منشآتها الحساسة، بينما أنشأت كوريا الشمالية “دولة تحت الأرض” تضم أنفاقا وقواعد صواريخ على أعماق قد تتجاوز 100 متر.
أما الصين، فتمتلك شبكة الأنفاق الهائلة المعروفة بـ”السور العظيم تحت الأرض” لتمويه منصات الصواريخ الباليستية، إلى جانب منشآت القيادة المحصنة في الجبال.
ومنذ الحرب الباردة، اعتمدت روسيا أيضا مراكز قيادة نووية محصنة في جبال الأورال مثل “يامانتاو” و”كوسفينسكي كامين”، والتي صممت لتحمل الضربات النووية والتقليدية على حد سواء.
وعليه، فإن تطوير قنبلة خارقة جديدة ليس مجرد خطوة لتعزيز القوة الهجومية الأميركية، بل لإعادة تشكيل ميزان الردع في عالم باتت فيه الجغرافيا العميقة جزءا من اللعبة العسكرية. فحين يختبئ الخصوم تحت الجبال، يصبح الردع التقليدي أقل فعالية، ما يدفع واشنطن للبحث عن سلاح يخترق ما تعتبره دول مثل إيران والصين وكوريا الشمالية “الملاذ الأخير”.
تطوير الجيل التالي من المخترقات هو رسالة مباشرة: لا توجد حصانة مطلقة تحت الأرض، مهما بلغ العمق.