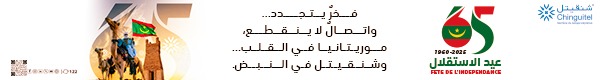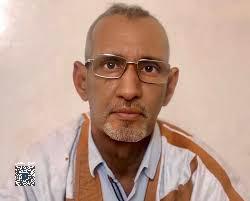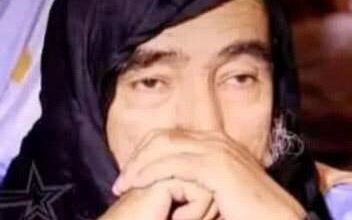هل نستطيع إعلان الاستقلال الثاني لموريتانيا

من ضفة النهر… إلى قلب الدولة: معركة السيادة المؤجلة
في الذكرى الخامسة والستين لاستقلال موريتانيا، لا يبدو السؤال المشروع هو: هل تحررنا من الاستعمار؟ بل: هل خرج الاستعمار فعلًا… أم غادر الباب ليعود من النافذة؟
فمنطقة الضفة — وهي أكثر فضاءات البلاد حساسية سياسيًا وعمقًا اجتماعيًا — تكشف لنا أن الصراع على الهوية لم يكن يومًا لغويًا ولا ثقافيًا، بل رهانًا استراتيجيًا للاستقلال نفسه. لقد أدركت الإدارة الاستعمارية منذ القرن التاسع عشر، أن وحدة هذا البلد تمر عبر لسانه المشترك، وأنّ المحظرة والقضاء والفقه والذاكرة الدينية تمثّل “لغة جامعة” تربط سكان الصحراء بالنهر، والعروبة بالإفريقية، والعلم المحلي بالمجال الجغرافي الأوسع.
ولذلك، وجّه الاستعمار جزءًا من استراتيجيته إلى الضفة تحديدًا، حيث جرى استجلاب مجموعات من دول الجوار وتوظيفها في إطار هندسة ثقافية وإدارية تهدف إلى خلق حالة «تنوع» قابل للاستغلال السياسي، بدل أن يكون تنوعًا منسجمًا في إطار الوطن الواحد. وقد بلغ ذلك ذروته بعد الاستقلال، حين دعم الرئيس السنغالي الأول ليوبولد سيدار سنغور أطروحات ترى في موريتانيا مجالًا ثقافيًا تابعًا للمحور السنغالي، بل تمّ الترويج لفكرة “الإقليم المشترك” على النهر، في محاولة لتسييل الحدود الهوياتية وربط القرار الوطني بنفوذ خارج الدولة.
ورغم أن الدولة الموريتانية استطاعت إحباط المشروع رسميًا، إلا أنّ جذوره الثقافية والإدارية ظلت نشطة داخل بعض النخب، ممّا جعل ملف الهوية الوطنية مقرونًا دائمًا بالسؤال السيادي: من يُحدِّد مستقبل البلاد؟ وهل تملك الدولة قرارها فعلًا في التعليم والثقافة والاقتصاد… أم أن إرث الاستعمار لا يزال يتحكم في النسيج الاجتماعي من خلال بوابة الضفة؟
وهكذا، لم يعد الجدل حول اللغة العربية مجرد جدل لغوي، بل أصبح جوهر معركة الوطن:
أهي لغة قوم؟ أم لغة مواطنة جامعة؟
أداة هيمنة؟ أم أداة عدالة وانصهار؟
خيار سياسي؟ أم شرط دولة؟
الاستقلال لم يكتمل بعد
لقد بنت موريتانيا دولة من العدم: لا شبكة طرق، لا مؤسسات، لا جهاز إداري، بل مجرد إرادة تأسيس. لكن بعد ستة عقود، ما زال ثقل التاريخ يُذكّرنا بأن الاستقلال الحقيقي لم يبدأ بعد، وأن معركة “القرار الوطني” هي آخر حلقات التحرر من الاستعمار.
والغائب الأكبر كان — وما يزال — الإرادة السياسية للتصنيع:
فالثروة تُصدّر خامًا، والشباب يُهمَل، والتعليم يترنّح، والعقود الكبرى في الصيد والمناجم والغاز تُدار بمنطق «شبه الاستلحاق»، وكأننا أمام عودة ناعمة للهيمنة الاقتصادية ما بعد الاستعمار.
إعادة صياغة هذه الاتفاقيات لم تعد قرارًا سياسيًا… بل شرط وجودٍ للدولة.
مسؤولية الرئيس… ومسؤولية التاريخ
يدخل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مأموريته الأخيرة، وفي التاريخ دروس لا ترحم: فالفرص لا تأتي مرتين.
وعليه فإن مستقبل موريتانيا يمر عبر ثلاثة مفاتيح واضحة:
- عزل شبكات المفسدين التي حكمت البلاد نصف قرن بالتوارث السياسي.
- إصلاح جذري للتعليم ليصبح عامل توحيد لا أداة تفريق.
- الانتقال من تصدير الثروة خامًا… إلى بناء قاعدة صناعية وطنية تحفظ السيادة وتخلق مجتمعًا منتجًا لا مستهلكًا.
وليس من باب الخطابة الدينية أن نذكّره، بل من باب المسؤولية التاريخية:
﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾
فالعبرة ليست في طول الحكم، بل في ميزان الأعمال.
وإن كان التاريخ لا ينسانا… فإن لقاء الله لا يغفل عنا.
الخلاصة
من الضفة إلى العاصمة، ومن الذاكرة إلى الاقتصاد… يتضح أن مشروع الدولة لم يُولد بعد كاملًا، وأن الاستقلال الأول كان بداية الطريق فقط. أمّا معركة الاستقلال الثاني، فهي معركة السيادة على العقل والثروة والقرار.
فهل نملك الشجاعة لبداية الاستقلال الحقيقي؟
أم نظل نُحيي ذكريات الاستقلال… بينما نفقده بصمت؟
حمادي سيدي محمد آباتي