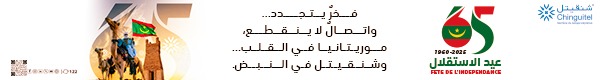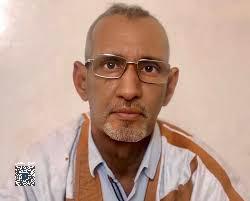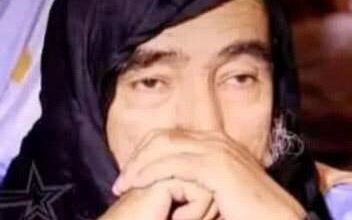إلى متى ستظل النخبة الحاكمة تُمعن في استغباء شعبها وتنتهز انكسار همّته

“حين تُساق الجماهير تحت وهج الخوف وبريق الطمع، تغدو الأوطان مسارح للتمثيل لا ميادين للوعي.”
لم يعرف المجتمع الموريتاني — أو بلاد البيظان بوجه عام — حُكمًا مركزيًا بالمعنى السياسي الحديث قبل قدوم الاستعمار، بل كانت أنماط التنظيم السائدة أقرب إلى أشكال حكم محلية محدودة النفوذ، كالإمارات القبلية التي لم تكن تسيطر على المجال الجغرافي المحيط بها تمامًا، ولا تحتكر القوة أو القرار. كانت القبائل الكبرى تحتفظ باستقلالها، والإمارة لا تمثل سوى موازنة بين مصالح القوى القبلية المتنازعة.
وحين جاء الاستعمار الفرنسي، لم يجد دولة ليهدمها، بل فسيفساء من الولاءات والانتماءات، فاستغلها في بناء سلطته عبر آلية “التفريق والسيطرة”، مُنتجًا بذلك بذرة النخبة الوسيطة التي ما زالت تحكمنا حتى اليوم.
من المقاومة إلى القابلية للاستغلال
لم تكن المقاومة الوطنية في تلك المرحلة “مقاومة” بالمعنى الحديث — أي حركة وطنية موحدة — بل كانت “تصديًا” لجماعات متفرقة، يجمعها رفض الاحتلال أكثر مما يجمعها مشروع الدولة. هذا الضعف في البنية السياسية والاجتماعية جعل المجتمع بعد الاستقلال هشًا، سهلَ الانقياد للنخب التي ورثت أدوات السيطرة الاستعمارية، فاستبدلت الراية دون أن تغيّر الذهنية.
اليوم، وبعد ستة عقود من الاستقلال، تتجلى المفارقة في أن من يفترض أنهم قادة التنمية أصبحوا “قططًا سِمانًا” يعتاشون على الجهل، ويستثمرون في فقر المواطن وولائه العاطفي. كلّما أرادوا تجميل صورتهم أمام الحاكم، حشدوا الفقراء في استقبالٍ صاخبٍ يخفي تحت زغاريده جوعًا مزمِنًا وكرامةً مهدورة.
هؤلاء يدركون أن بقاءهم مرهون بإبقاء الشعب في قفص الخوف والطمع: الخوف من فقدان الفتات، والطمع في عطية المسؤول.
تزييف الوعي: التعليم كضحية أولى
حين يُراد لشعبٍ أن يبقى خانعًا، يكون التعليم أول ما يُستهدف. وقد جرى في موريتانيا القضاء على التعليم بوصفه أداة للتحرر، واستبداله بمسرحياتٍ تُسمّى إصلاحاتٍ تعليمية هدفها الحقيقي استدرار التمويلات الخارجية لا صناعة الوعي الداخلي.
تخرج المدارس اليوم أجيالًا محبطة، لا تمتلك أدوات التفكير النقدي، بل تردّد ما يُملى عليها، وهو ما يضمن للنخب استمرار السيطرة عبر “إدارة الجهل” بدل إدارة المعرفة.
شعب الصحراء بين إرث الحرية وثقافة الخضوع
يُفترض أن يكون ابن الصحراء مولعًا بالحرية، متشبّعًا بالكرامة، رافضًا للقيود. غير أن تاريخنا يكشف مفارقة أخرى: فقد تحوّل ذلك المزاج الصحراوي، بفعل القسوة والحرمان، إلى قابليةٍ للاستسلام حين تُغريه الوعود الزائفة.
الحروب البينية التي ملأت صفحات تاريخنا لم تكن من أجل العدالة أو إقامة حكمٍ رشيد، بل في معظمها صراع على الموارد والنفوذ، فاستُبدلت قيم الحرية بعادات الولاء والزعامة، حتى غابت فكرة الدولة الجامعة.
خطر التغيير العنيف
إذا كنتم ترون — كما يرى كثير من المراقبين — أن التغيير بات حتميًا، فإنّ غياب الوعي سيجعل هذا التغيير عنيفًا وغير مدروس، وهو ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على وحدة الشعب والإقليم معًا.
فموريتانيا بلد متعدّد الإثنيات والمكوّنات، وقد أسهمت سياسات الحكام في توسيع الشقّة بين مكوّناته من خلال تغذية خطاب الكراهية، وتشجيع من يشيعونه. غير أن الخطر الأكبر اليوم هو أن هؤلاء الذين تمّ اللعب بعواطفهم وتغذيتهم على الغضب لم يعودوا قابلين للتحكم في ردود أفعالهم، ما يجعل احتمالات الانفجار الاجتماعي قائمة ما لم يُبادر الحكم إلى إصلاحٍ حقيقي يردّ الثقة بين الدولة والمجتمع.
هل من أفق للتغيير السليم؟
التغيير لا يأتي بالصدفة، ولا يُستورد من الخارج، بل يُصنع من الداخل حين تتوافر ثلاثية الوعي، والإرادة، والتنظيم.
لكن الوعي في بلادنا محاصر، والإرادة مُخدّرة، والتنظيم مغيّب. ومع ذلك، فالتاريخ يعلّمنا أن الشعوب قد تنام لكنها لا تموت. وحين تدرك يومًا أن كرامتها لا تُشترى، وأن التعليم لا يُصلح بالبيانات، وأن الوطن لا يُختزل في موكب استقبال، عندها فقط يبدأ فجر التغيير الحقيقي.
حمادي سيدي محمد آباتي