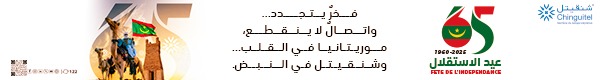من روّاد الطيران العثماني إلى حلم السيادة الجوية التركية

في باحة ضريح صلاح الدين الأيوبي بدمشق يرقد ثلاثة من روّاد الطيران العثمانيين: صادق بك، وفتحي بك، ونوري بك. شارك هؤلاء في رحلة جوية شملت خمس طائرات عثمانية هدفت إلى رفع الروح المعنوية للجيش وجمع تبرعات لتطوير القوات الجوية. امتد مسار الرحلة لأكثر من 2500 كيلومتر شمل مدنًا ومحطات عدة من إسطنبول إلى الإسكندرية مرورًا بإسكي شهير، أفيون قره حصار، قونية، أضنة، حلب، حمص، بيروت، دمشق، القدس، العريش، بورسعيد، والقاهرة.
انطلقت الرحلة في 8 فبراير/شباط 1914، لكن مأساةً ألمّت بها في الشهر نفسه: تحطمت طائرة يقودها فتحي وصادق بك في قرية كفر حارب في الجولان قرب بحيرة طبريا، فيما سقطت طائرة نوري بك لاحقًا في البحر قبالة سواحل يافا. دفن الثلاثة في جوار ضريح صلاح الدين، كرسالة رمزية تربط بين الإرث العسكري العثماني والهوية الإسلامية العسكرية.
على مدى قرنٍ وأكثر تطور سلاح الجو التركي مطًّا واهتدى إلى مسارات متنوعة، وشهد تحديات مالية وتقنية وسياسية. وفي الآونة الأخيرة عاد ملف تحديث الأسطول الحربي إلى الواجهة، لا سيما بعد توافقات ومباحثات رئاسية تناولت إمكانية بيع طائرات أميركية لأنقرة؛ إذ ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمر مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض في 25 سبتمبر/أيلول 2025.
يروي كتاب “الفرسان الطائرون” قصة ولادة صناعة الطيران في الأراضي التركية والعقبات التي أجهضت محاولات التصنيع المبكرة. استشعر العثمانيون أهمية السيطرة على الجو بعد تجارب حرب طرابلس عام 1911، فأسسوا أولى مدارس الطيران في يشيلكوي عام 1912 وأطلقوا حملات شعبية لتمويل شراء الطائرات. ونجحوا في اقتناء طائرتين من فرنسا، وكان فيسا بك من أوائل من حلقوا في سماء الأناضول.
لكنّ الحروب المتتالية، لا سيما الحرب العالمية الأولى، أجهضت جزءًا من الطموحات المحلية في التصنيع الجوي، رغم استمرار حلم الاستقلال الصناعي في الجمهورية التركية الوليدة. فقد دُشنت جمعيات ومصانع وبرامج تدريبية طوال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وتم التعاون مع شركات وخبرات أجنبية لتأسيس قاعدة إنتاجية، وظهرت مشاريع مهمة مثل “تومتاش” ومشروعات مصنعة في قيصري.
مع تزايد التحولات الجيوسياسية بعد الحرب العالمية الثانية بدا الدور الأميركي حاسمًا في إعادة تشكيل القوة الجوية التركية؛ فقد دمجت مساعدات وما تبعها من شراكات أنماطَ تجهيز وتدريب تقلد النموذج الأميركي، وهو ما أعطى تركيا قدرة عسكرية سريعة لكنه ربطها أيضًا بسلاسل توريد خارجية أعاقت الاستقلال الصناعي لاحقًا. وبعد صدمة عقوبات السبعينيات وقيود التوريد إثر أزمة قبرص في 1974، بدأت أنقرة مراجعة سياساتها الدفاعية والسعي نحو اكتفاء ذاتي أوسع، فأنشأت مؤسسات محلية مثل “توساش” و”أسيلسان” و”هافيلسان” التي شكّلت العمود الفقري للصناعات الدفاعية التركية الحديثة.
تطورت العلاقة مع شركاء أجانب إلى شراكات تصنيع محلية؛ فقد جرى تجميع طائرات إف-16 بالشراكة مع شركات أميركية في ثمانينيات القرن الماضي، بينما بقيت تحديات التحديث والتجديد قائمة مع تقدم التكنولوجيا وظهور أجيال جديدة من المقاتلات. مفهوم “أجيال المقاتلات” عكس هذا التطور التقني بدءًا من الطائرات النفاثة المبكرة وحتى منصات الجيل الخامس التي تجمع بين التخفي والاستشعار المتقدّم وربط الشبكات.
تقف تركيا اليوم أمام خيارات استراتيجية عدة لتحديث أسطولها: خيار أميركي يتمثل في العودة لبرنامج إف-35، وخيار أوروبي عبر اقتناء طائرات من طراز يوروفايتر كحل مرحلي، وخيار وطني طموح بالاعتماد على مشروع “قآن” للمقاتلة المحلية من الجيل الخامس. كل خيار يحمل مزايا وتحديات سياسية وتقنية ومالية؛ فالإف-35 يمثل الأفضل تقنيًا لكنه معقّد سياسيًا، واليورو فايتر حل عمليًا مرحليًا، بينما مشروع “قآن” مطلب سيادي يتطلب وقتًا وموارد ضخمة لإتمامه.
نجاح أي مسار يتطلب أساسًا علميًا وصناعيًا راسخًا: استثمارًا طويل الأمد في المعرفة والكوادر والهياكل المؤسسية، وبناء سلاسل إمداد متينة، وضمان تمويل مستقرّ، وتوسيع شراكات تتيح نقل التكنولوجيا وتخفيف الأعباء المالية—كما أظهرت تجربة تصدير طائرات “قآن” إلى أسواق مثل إندونيسيا كيف يمكن للعقود الخارجية أن تُسهِم في استدامة المشروع.
في نهاية المطاف، يظل امتداد الإرث التاريخي للطيارين الأوائل حجرَ انطلاقٍ نحو طموح أكبر: بناء قدرة جوية متكاملة تُوفّر السيادة الاستراتيجية لأنقرة. تحقيق هذا الطموح يتطلب توازنًا بين تلبية الاحتياجات العاجلة والرهان على بناء بنية صناعية محلية قادرة على امتلاك القرار العسكري بعيدًا عن قيود التوريد الدولية — وهو الطريق الذي تسعى إليه تركيا عبر مزيج من تحديث الأسطول، وتنوّع مصادر التسليح، وتسريع مشاريع التصنيع المحلي.