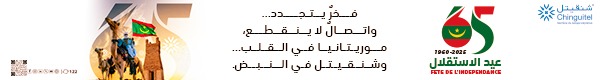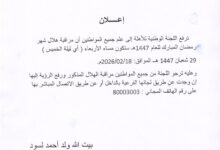أقليةٌ ساحقة وأغلبيةٌ مسحوقة: حين تُجهض النخب المصطنعة آمال الوطن

في موريتانيا، تُكرّس الأقلية الفرنكفونية موقعها كـ”أقلية ساحقة” تتحكم في مصائر “أغلبية مسحوقة”، في مفارقة فجة تُذكّر بمفهوم العنف الرمزي عند بيير بورديو، حيث تُمارس الهيمنة لا بالقوة، بل عبر السيطرة على أدوات التأهيل الاجتماعي واللغوي والرمزي، وعلى رأسها التعليم واللغة.
حين انسحبت فرنسا من موريتانيا، لم يكن ذلك بفعل انتصار مشروع وطني متكامل، بل انسحاب طوعي خاضع لتقديراتها الاستراتيجية، كما يؤكد العديد من المؤرخين. فالمواجهة التي حصلت كانت دينية الطابع، لا وطنية؛ لأن مفهوم “الوطن” ذاته لم يكن قد تشكّل في الوعي الجمعي، وهو ما يجعل من الأدق وصف أولئك المقاومين بـ”المجاهدين” لا “الوطنيين”، كما يشير محمد عابد الجابري في تحليله للفكر العربي الحديث، الذي يبيّن كيف تأخر الوعي الوطني مقارنة بالوعي الديني أو القبلي.
ومع الاستقلال، تشكلت طبقة حاكمة فرنكفونية، تعلمت في مدارس المستعمر وتشبّعت بقيمه ومفاهيمه. هذه النخبة، وفق تحليل عبد الله العروي في كتابه الإيديولوجيا العربية المعاصرة، لم تسع إلى القطع مع الاستعمار ثقافيًا، بل ورثته واستثمرت أدواته لضمان استمرار الهيمنة الطبقية والثقافية على باقي مكوّنات الشعب.
فكل محاولة لتعريب التعليم والإدارة كانت تواجه بالعرقلة، لأن اللغة ليست مجرد أداة تواصل، بل أداة فرز طبقي وسيطرة رمزية. وقد أبرز عالم الاجتماع الجزائري عبد المالك صياد هذا البُعد في تحليله لوضعية المدرسة في المجتمعات ما بعد الكولونيالية، حيث تصبح اللغة الأجنبية شرطًا للنجاح الاجتماعي، وتُقصى من لا يتقنها من المشاركة الفعّالة في الشأن العام.
فشل مشروع التعريب لم يكن عفويًا، بل مقصودًا. وقد أُفرغ التعليم من جوهره عمداً، ليظل حكراً على أبناء النخبة. هذه “العصبوية الحديثة” كما سماها ابن خلدون، تحوّلت إلى ما يشبه الإقطاع الإداري، حيث تُوزّع المناصب على أساس الولاء، أو النسب، أو التبعية، لا الكفاءة.
ولعلّ من أبرز النماذج الدالة، حالة موظف بسيط لا يحمل سوى شهادة الباكالوريا، دخل الداخلية بتوصية من وزير مدني، ثم ترقى دون توقف حتى أصبح وزيراً ورئيس مجلس إدارة. والمفارقة أن الوزير الذي رعاه في بدايته سلّمه ذات يوم مظروفًا عند مغادرته المنصب، فلما فتحه وجده يحتوي على تقارير استخباراتية ضده، كتبها ذلك الموظف نفسه! هذا النموذج هو تجلٍ لمقولة ميكيافيلية قديمة: “من يُصعدك، لا تأمن له”.
مثل هذه النماذج كثيرة، وتتكرر بإصرار. فحتى من أنهكهم المرض والعجز لا يُقصون من السلطة، بل يُعاد تدويرهم ضمن شبكات محسوبة على مراكز النفوذ، وتُقيّد مهامهم بأن تظل الفائدة ضمن أبنائهم فقط، ضمانًا لاستمرار الإرث الطبقي والبيروقراطي داخل الأسرة أو القبيلة أو الدائرة.
هكذا، تترسخ حالة ما سماه عالم الاجتماع المغربي المهدي المنجرة بـ”الاستعمار الداخلي”، حيث تُعاد إنتاج التبعية عبر نخبة محلية متغربة، لا تملك مشروعًا وطنيًا، بل تسعى لتكريس مواقعها عبر “قتل الحلم” في أي نخبة بديلة.
هذه الوضعية تُنتج ما يسميه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر بـ”الاحتكار الشرعي للفرصة”، حيث تُحتكر الوسائل المشروعة للترقي الاجتماعي (مثل التعليم والتوظيف) من قبل فئة ضيقة، فيمنع الآخرون من الصعود إلا إذا تبنوا قيم الفئة الحاكمة أو انخرطوا في شبكاتها (زواج، تملق، نفاق).
في ظل هذا الوضع، لا غرابة أن تشعر النخبة الوطنية الصادقة باليأس. فالمجال السياسي والبيروقراطي مغلق أمامها، وحلم الإصلاح يصطدم بجدار سميك من المافيوية المؤسسية. وهكذا، يُصبح بعض المثقفين إما نفاقيين يتقنون لعبة الولاء، أو ينسحبون بهدوء، مخلين الساحة لأقلية متسلطة تستهلك كل شيء، وتنتج اللاشيء.
حمادي سيدي محمد آباتي