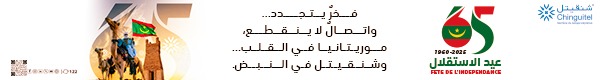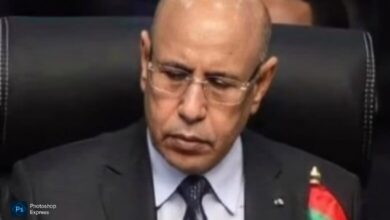بلد بلا ذاكرة مركزية.. كيف يُنقذ وطن بُني على فراغ؟”

لا يُسأل بلدٌ عن ماضيه إن لم يُتح له أن يصنعه بنفسه، لكن من حق الأجيال أن تسأل: كيف السبيل لإنقاذ وطن لم يعرف سلطة مركزية موحدة قبل أن تبسط فرنسا عليه سيطرتها الاستعمارية؟ وطنٌ لم يُمهَّد له أن يتبلور كدولة، بل جيء به إلى الوجود على عجل، في سياق تقسيم استعماري للقارة، وكان التأسيس خاليا من أي توافق اجتماعي أو مرجعية حضارية جامعة.
فرنسا حين دخلت هذا الإقليم، لم تجد مقاومة شعبية واسعة، بل واجهتها جماعات جهادية معزولة، ذات ارتباطات وثيقة بالمغرب الذي كان بدوره في قبضة الاستعمار الفرنسي. وحين استتب لها الأمر، أسست عاصمة في نقطة فراغ سكاني، لا عمران فيها ولا تواصل عضوي مع نسيج اجتماعي قائم، ثم أوكلت شؤون الإدارة إلى غرباء: فرنسيين، وسنغاليين، وماليين، وجزائريين، ليبدأ بذلك المسار المشوه لبناء “دولة بلا قاعدة”.
وقد أفرزت هذه المرحلة ما يمكن أن نسميه “جيل المولدين”، وهو جيل مختلط الهويات، نتاج تلاقح غير متكافئ بين عناصر استعمارية ونساء موريتانيات من فئات مستضعفة، أو أبناء لبعض الزعامات القبلية الذين تم إعدادهم ليكونوا مجرد منفذين للأوامر. هؤلاء شكلوا البنية التحتية البشرية لمنح الاستقلال الشكلي الذي ظل يخدم بعمق مصالح المستعمر، مستمرا في حصد خيرات البلاد عبر نخبة “محلية” مصنّعة على المقاس الفرنسي.
ولأن التأسيس كان هشّا، فإن أول رئيس للبلاد، المختار ولد داداه، ورث كيانا فاقد التوازن. ومع ذلك، حاول اجتراح بعض السياسات التي تتجه نحو بناء هوية وطنية، من قبيل تعميم التعليم ومنع الاجتماعات القبلية. لكن العمق الاجتماعي المرتبط بالمستعمر، من زعماء قبائل وشيوخ طرق، حال دون تحقق انتقال حقيقي نحو المواطنة. ويكفي للتدليل على ذلك ما حدث في مؤتمر “الاك”، حين عبّر كثيرون عن ارتباط وجداني بفرنسا، مدفوعين بتلاقي مصالحهم مع سلطات الاستعمار، التي أوكلت لهم مهمة الجباية مقابل نصيب معلوم.
تكرّس بذلك نمط من الطبقية العنيفة، ظل جرحا مفتوحا في بنية المجتمع، ولم تنجح الدولة الوليدة ـ التي كانت خداجا، بلا مؤسسات فعلية ولا قاعدة شعبية موثوقة ـ في الحد منها. بل إن الحدود نفسها كانت ولا تزال غير مستقرة، والإقليم عرضة لتآكل جغرافي ودمغرافي، وسط حالة مدنية مضطربة، وسهولة تَسرُّب جماعات من دول الجوار المتداخلة إثنيا.
واليوم، بعد ما يناهز سبعة عقود من الاستقلال المعلن، لا تزال موريتانيا غارقة في الفساد والمحسوبية والظلم، وقد جرى تدمير التعليم والإجهاز على العدالة الاجتماعية. باتت السلطة هي المبتغى والمطمع، لا لأنها وسيلة بناء، بل لأنها تتيح الاغتناء والسطو. وهي سلطة لم تعرف المعارضة فيها سوى هامش ضيق، ظل يحاول أن يتمدد داخل منظومة مغلقة.
وإن كان من السياسيين من كسر ـ ولو جزئيا ـ جدار الصمت، وحاول مخاطبة الجمهور خارج المألوف، فهو برام الداه اعبيد، رغم مآخذ كثيرة يمكن تسجيلها عليه. فالرجل ـ وإن شاب خطابه بعض التهريج أحيانا ـ يبدو أنه الوحيد الذي تحدّى بشكل علني الثوابت الطبقية التي قامت عليها الدولة. ولئن كانت لغته لا تخلو من عواطف مراهقة واستعطاف لجمهور محدود الوعي، فإن له بعض العذر في واقع تجف فيه الموارد الأخلاقية والسياسية ويضيق فيه الأفق.
إن إنقاذ موريتانيا لا يمكن أن يتم بإعادة تدوير وجوه النظام القائم، ولا عبر التسليم بالأمر الواقع، بل بقراءة نقدية صريحة لتاريخ الدولة المصطنعة، وإعادة تأسيسها على قاعدة مواطنة، وهوية جامعة، وعدالة اجتماعية، ومشروع تربوي يعيد للمدرسة اعتبارها، وللدولة سيادتها على القرار السياسي والاقتصادي.
حمادي سيدي محمد آباتي