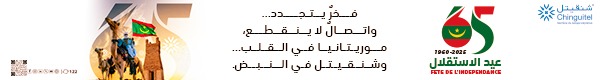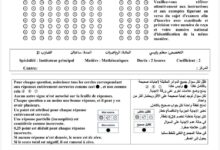الجيوبولتكس: المفهوم، النظريات، والتطبيقات في عالم متغيّر
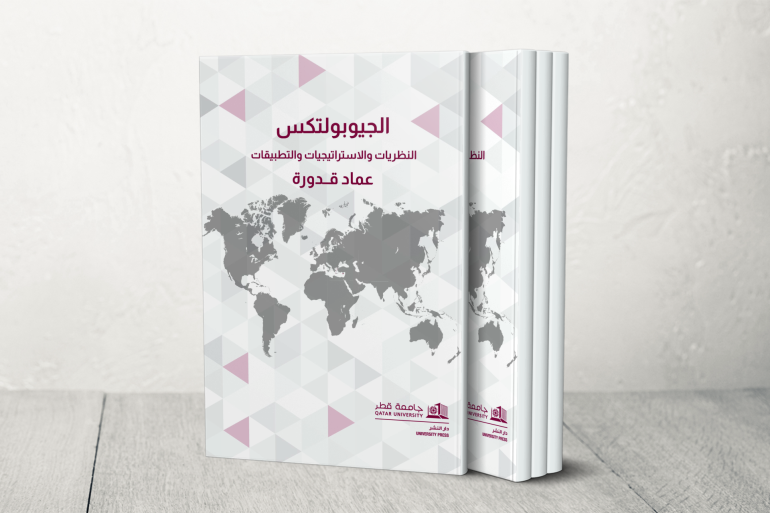
يتردد مصطلح “الجيوبولتكس” ومشتقاته، وعلى رأسها “الجيوسياسي”، بشكل لافت في الأوساط الأكاديمية والتحليلات السياسية والتغطيات الإعلامية. فقد أصبح شائعًا وصف مناطق أو أزمات أو سياسات بأنها “جيوسياسية”، أو تفسير تحولات معينة بأسباب “جيوسياسية”، ما يعكس الحضور القوي لهذا المفهوم في التفكير المعاصر.
ومع أن هذا الاستخدام المتكرر يشير إلى الأهمية المتزايدة للجيوبولتكس، فإن كثيرًا من التطبيقات الميدانية للمصطلح قد تفتقر إلى الدقة أو تنحرف عن مدلوله العلمي، ما يستدعي فهماً أعمق له ولمجاله المعرفي.
الكتاب المرجعي الجديد: مقاربة شاملة للجيوبولتكس
ضمن هذا السياق، يأتي كتاب “الجيوبولتكس: النظريات والإستراتيجيات والتطبيقات” للدكتور عماد قدورة، الصادر عن دار نشر جامعة قطر في مايو/أيار 2025، ليملأ فراغًا في المكتبة العربية، عبر تقديم معالجة متكاملة للمفاهيم والنظريات الجيوسياسية، وتحليل أبعادها الإستراتيجية، وتطبيقاتها على السياسات العالمية الراهنة.
الكتاب لا يقتصر على عرض المعلومات، بل يتبنى مقاربة تحليلية ومقارنة، تسعى لتفكيك الأدبيات الجيوسياسية الكلاسيكية والحديثة، وفهمها في سياقاتها الزمنية والسياسية.
فهم المفهوم: نحو تعريف عملي للجيوبولتكس
يعرض المؤلف بداية المفهوم من خلال استعراض أبرز التعريفات والنقاشات النظرية حوله، ثم يتبنى تعريفًا وظيفيًا يركّز على مضمون الجيوبولتكس بوصفه علمًا يدرس كيف تبني الدول قوتها وتأثيرها الخارجي عبر تسخير عناصر الجغرافيا والموارد في خدمة أهدافها السياسية.
ويعالج المؤلف النظريات التأسيسية للجيوبولتكس في سبعة فصول، معرّفًا بأبرز المنظرين الأوائل كـ فردريك راتزل، ورودولف كيلين، وألفريد ماهان، وهالفورد ماكيندر، وكارل هاوسهوفر، ونيكولاس سبايكمان، عارضًا أفكارهم ضمن سياقاتهم السياسية والاجتماعية.
ومن بين النظريات التي تناولها: النظرية العضوية لنمو الدولة، ونظرية المجال الحيوي، ونظرية الفضاء الجيوسياسي الكبير، ونظرية القوة البحرية، ونظرية قلب الأرض، ونظرية حافة المحيط، وغيرها من المفاهيم التي تسعى لتفسير علاقات القوة على المستوى العالمي.
الجيوبولتكس المعاصر: استراتيجيات القوى الكبرى
في ستة فصول لاحقة، تناول قدورة الاتجاهات الجيوسياسية الحديثة لدى القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا. كما ناقش المفاهيم المرتبطة بها، مثل الأوراسية الجديدة، والحزام والطريق، والاستقلال الذاتي الإستراتيجي الأوروبي، والاحتواء الجديد.
واستعرض المؤلف آراء مفكرين وسياسيين معاصرين مثل هنري كيسنجر، وزبيغنيو بريجنسكي، وألكسندر دوغين، وإيف لاكوست، وجيوفري سلون، وغيرهم، مبينًا تأثيرهم في رسم السياسات الدولية المعاصرة.
الجيوبولتكس النقدي: مراجعة للمفاهيم الكلاسيكية
خصص الكتاب أيضًا مساحة لمقاربة “الجيوبولتكس النقدي”، وهو اتجاه ظهر مع انتشار الشبكات والعولمة، ويهتم بعناصر جديدة في تحليل القوة الجيوسياسية، كالبعد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الحراك الشعبي.
ورغم أهمية هذا الاتجاه في فتح آفاق جديدة، فإن المؤلف يقدّم نقدًا له، كونه لم ينجح في تقديم بدائل واضحة للجيوبولتكس الكلاسيكي، ولم يتبلور في صورة سياسات عملية قابلة للتطبيق.
نقد المعادلات الكلاسيكية: تفكيك المسلمات
تتميّز مقاربة المؤلف بقراءته النقدية للنظريات السائدة، حيث لم يسلّم بالمعادلات الشهيرة مثل “من يسيطر على قلب الأرض يحكم العالم”، بل أعاد تفسيرها ضمن سياقاتها، موضحًا أن تلك العبارات لم تكن غاية بذاتها، بل نتيجة لتصورات سياسية معقدة هدفها فهم موازين القوى في أزمنة محددة.
كما قدّم قراءة متوازنة لمفاهيم القوة، مبينًا أن منظّري الجيوبولتكس لم يكونوا منقسمين بالمطلق بين من يؤيد القوة البرية ومن ينحاز للبحرية، بل إن أغلبهم دعا إلى مزيج متكامل من أدوات القوة بحسب طبيعة الصراع وساحة المواجهة.
أوراسيا والاحتواء الجديد: من التنافس إلى الاصطفاف
يرى الكتاب أن مركزية أوراسيا لا تعني بالضرورة أنها “قلب العالم” في كل الأوقات، بل إن ذلك يختلف باختلاف مصادر القوة وأدواتها في كل عصر، وهو ما يجعل من منطقة آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية اليوم ساحة صراع محورية بين روسيا والقوى الغربية.
ويشرح المؤلف أن الاستراتيجية الأميركية الحالية في “الاحتواء الجديد” للصين وروسيا، وإن استلهمت بعض أفكار سبايكمان وماهان، فإنها تختلف جذريًا عن سياسة الاحتواء التقليدية في الحرب الباردة، حيث أصبحت اليوم تقوم على أدوات متنوعة: من التحالفات العسكرية، إلى العقوبات الاقتصادية، مرورًا بالحرب التكنولوجية والمعلوماتية.
مفاهيم مجاورة: الجيوستراتيجية والجغرافيا السياسية
أحد الإسهامات الفريدة في الكتاب هو التمييز المنهجي بين مفاهيم الجيوبولتكس، والجيوستراتيجية، والجغرافيا السياسية. فبينما الجيوبولتكس يركّز على سياسات الدول الكبرى وتوظيف الجغرافيا في الصراع، فإن الجيوستراتيجية تقتصر على الشؤون العسكرية، دون أن تكون لها نظرية مستقلة أو مؤسسون معروفون.
أما الجغرافيا السياسية، فهي أشمل وأكثر حيادية، وتركز على توصيف العلاقة بين الجغرافيا والسياسة في جميع الدول، بصرف النظر عن قوتها أو تأثيرها.
نظريات قديمة في سياقات جديدة
يرى قدورة أن العديد من المفاهيم الجيوبوليتيكية القديمة لا تزال حاضرة في السياسات المعاصرة، وإن بصيغ جديدة. فمثلاً، تمثل المبادرة الصينية “الحزام والطريق” امتدادًا لرؤية مركزية الصين في التاريخ، بينما يعكس “الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي” تطلع فرنسا وألمانيا إلى استعادة مكانتهما العالمية بعيدًا عن الوصاية الأميركية.
كذلك تمثل نظرية “قلب الأرض” أساسًا لتوسّع حلف الناتو شرقًا وضم أوكرانيا، ما يفسر جزءًا من رد الفعل الروسي في حرب 2022. أما نظرية “حافة المحيط”، فتظل مرجعية لفهم التحالفات الأميركية ضد روسيا والصين، خاصة بعد ضم القرم عام 2014.
نحو وعي جيوبوليتيكي مستقل
يختم المؤلف كتابه بتأكيد أهمية بناء وعي جيوبوليتيكي مستقل، يدرك أدوات القوة وطرق التأثير، لكنه لا يكرر أخطاء القوى الكبرى في فرض الهيمنة أو صياغة مفاهيم الخير والشر وفق مصالحها. فكما أن الجيوبولتكس يمكن توظيفه لخدمة القوة والهيمنة، يمكن أيضًا أن يُستخدم لفهم التوازنات، وبناء سياسات خارجية مسؤولة تراعي العدالة والسلام.
ويؤكد أن فهم الجيوبولتكس لا يعني قبوله كما هو، بل دراسته نقديًا واستخدام أدواته في تحقيق مصلحة الشعوب، لا في تكريس الاستعلاء والوصاية. فمن يتحمل كلفة السياسات الجيوسياسية غالبًا هم الأضعف، ممن لا صوت لهم في خرائط المصالح الكبرى.