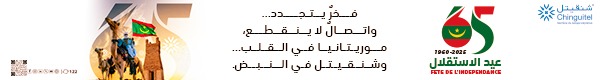موريتانيا وخطر الشريط الحدودي مع السنغال ومالي: تهديد صامت من رحم التفاوت الطبقي

في الشريط الحدودي الرابط بين موريتانيا وكلٍّ من السنغال ومالي، تنتظم المجتمعات المحلية ضمن أنظمة اجتماعية تقليدية ترتكز على تصنيفات طبقية موروثة من الماضي، تتوزع بين “نبلاء” و”عبيد سابقين”. وعلى الرغم من أن مثل هذه التصنيفات قد عفى عليها الزمن، إلا أن الواقع في هذه المناطق يُظهر بقاءها كمصدر توتر مستمر وصراع مزمن حول من يتولى الزعامة التقليدية، أو من يحق له ملكية الأرض، أو من يتمتع بالسلطة الدينية.
وتشهد هذه المنطقة صراعات متكررة بين المزارعين والرعاة، وأخرى تنفجر لأسباب أكثر تعقيدًا تتصل بالهوية والانتماء الاجتماعي. وتُترك معالجة هذه النزاعات غالبًا للسلطات المحلية، التي كثيرًا ما تكون منحازة أو عاجزة عن تقديم حلول عادلة، مما يكرّس هشاشة الوضع الأمني والاجتماعي ويحوّل المنطقة إلى بيئة مثالية لولوج الجماعات المتطرفة.
هذه الجماعات تستغل مشاعر الظلم والإقصاء لتغذية نزعات الانتقام، وتبيع فكرة “عدالة السماء” كبديل عن عدالة الأرض الغائبة. وهكذا، تتحول الإحباطات الناجمة عن الإقصاء الطبقي إلى طاقة قابلة للتعبئة في مشاريع العنف والتجنيد الإرهابي، لا سيما في أوساط الشباب الذين وُلدوا في عالم لا يعترف بكرامتهم.
وموريتانيا كبلد تقع اليوم تحت تهديد حقيقي، ليس فقط من الخارج، بل من الداخل؛ بسبب ترِكة اجتماعية تُمعن في تكريس التفاوت. وقد سنحت لنا الفرصة، كما سنحت لغيرنا من الشعوب، أن نعالج هذه البُنى الطبقية عبر أدوات مدنية سلمية، كما حصل في أوروبا حين لعبت المدرسة دورًا مركزيًا في “التطبيع الاجتماعي”، إلا أن هذه الفرصة وُئدت باكرًا بفعل تحالفات نخبوية ولوبيات نافذة.
وفي مفارقة مريرة، نجد أن بعض المتصدّين لقضايا العدالة الاجتماعية في الخطاب السياسي المعاصر، قد ساهموا في تعميق الفوارق الطبقية بدلًا من تجاوزها. بل إن منهم من استغلّ قضية الرق ليحوّلها إلى كيد سياسي، مُصوّرًا العنصر “البيظاني” وكأنه الوحيد الذي مارس الظلم، في حين تُمارَس العنصرية والطبقية اليوم بأبشع صورها في المناطق الحدودية، حيث يُمنع دفن “العبد السابق” بجوار “النبيل”، ولا يُسمح للأول بالجلوس على مقعد جلس عليه الثاني، سواء أكان نجّارًا أو حدّادًا.
هذه المعطيات ليست تفاصيل عابرة، بل علامات إنذار خطيرة تنذر بخطر وجودي حقيقي. فحين تتغلغل التنظيمات الإرهابية في بيئات مشبعة بالظلم والإقصاء، وتجد تربة مهيأة من طبقيةٍ لم تُجتث، فإن مشروع العنف يجد روافده من مآسينا الذاتية قبل أن يحتاج إلى دعم خارجي.
لقد آن الأوان لفتح نقاش وطني حقيقي، يتناول هذا الخطر الصامت، ويتعامل معه لا بوصفه “مسألة حدود” بل “أزمة بنيوية”، تتطلب إعادة تشكيل منظومتنا التعليمية، وتجديد خطابنا الديني، وفتح آفاق اقتصادية تعيد توزيع الفرص بعدل بين كل أبناء الوطن، مهما كان أصلهم أو لونهم أو تراتبيتهم الاجتماعية.
حمادي سيدي محمد آباتي