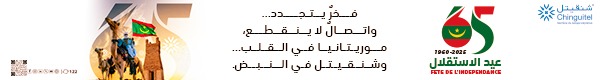موريتانيا بين انسداد الأفق وتكلّس النخب: أيُّ مآل ينتظر الدولة والمجتمع؟

مدخل: حين يصبح الفساد نظامًا لا ظاهرة
لم يعد الفساد في موريتانيا مجرّد سلوك منحرف لبعض الأفراد، ولا حالة طارئة على جسم الدولة، بل صار بنيةً مؤسسية متكاملة تحكمها شبكات المصالح، ويُعاد إنتاجها سياسيًا واجتماعيًا عبر تحالف معقّد بين النخب الإدارية والإقطاع السياسي والولاءات التقليدية.
إن ما نعيشه ليس “فساد أشخاص”، بل فساد منظومة تتغذّى على غياب الرقابة، وضمور الثقافة المدنية، واستقالة الضمير الجمعي، وتواطؤ جزء كبير من الطبقة المتعلّمة.
لقد أصبح سوء الحكامة سمة مهيمنة على إدارة الدولة، وتحوّل المنصب العمومي إلى مورد للثراء الشخصي، بينما صارت المصلحة العامة ضحية دائمة للتوازنات السياسية ولصفقات الولاء.
في هذا السياق، لم يعد السؤال: من يفسد؟، بل: من يستطيع أن يعمل دون أن يُفسِد أو يُفسَد؟
خريطة سياسية فقدت البوصلة
الخريطة السياسية الموريتانية تبدو اليوم كفسيفساء من الولاءات والأشخاص أكثر منها منظومة أفكار أو مشاريع.
فالأغلبية الحاكمة تمارس السلطة دون رؤية استراتيجية، وتتعامل مع الدولة بوصفها غنيمة تدار بالحسابات الشخصية والجهوية. أما المعارضة، فقد تحولت إلى جزر متباعدة، يغلب عليها طابع الزعامة الفردية والتموقع الانتفاعي، أكثر من الدفاع عن مشروع وطني بديل.
أحزاب عقائدية كانت تحمل وعودًا بالتحرر من الولاءات الضيقة، انتهت هي الأخرى إلى استنساخ منطق النظام نفسه، في التبرير والمساومة والمكاسب المرحلية.
وباستثناء قلة قليلة من الشخصيات التي يُشهد لها بالنزاهة الفكرية وطهارة اليد، فإن الغالبية من النخب السياسية تدور في فلك واحد: إما وجوه أُعيد تدويرها من داخل النظام، أو معارضون يبحثون عن نصيبهم من الريع عبر الضغط الإعلامي أو التلويح بالتحالف.
إننا أمام “طبقة سياسية” لا تؤمن بالبديل بقدر ما تُتقن إدارة الفراغ.
الشرعية المأزومة: من القبيلة إلى الدولة المتعذّرة
لم تشهد موريتانيا ــ منذ الاستقلال ــ انتقالًا حقيقيًا من الشرعية التقليدية (القبيلة، الجهة، الزاوية) إلى شرعية الدولة الحديثة القائمة على القانون والدستور.
فما زالت السلطة تُمنح وتُنتزع على أسس الانتماء قبل الكفاءة، وعلى منطق الوساطة قبل الاستحقاق.
المجتمع، في عمقه، لم يتحرر بعد من البنى الأهلية التي تتغذى على التبعية والولاء، وهي البنى ذاتها التي استخدمها المستعمر بالأمس لتفكيك المقاومة، ثم استخدمها النظام الوطني لاحقًا لإدارة الولاء السياسي وضمان الاستقرار السلطوي.
لقد أُجبر الحكام في التسعينات على تبني ما سُمّي بالديمقراطية بعد انطفاء الصراع العسكري، لكن ما حدث كان إعادة تأهيلٍ للإقطاعيين في ثوبٍ انتخابي.
فمنذ 1992، استعادت أكثر من سبعمائة شخصية تقليدية ــ إضافة إلى نحو مائتي أسرة موروثة من زمن فرنسا ــ مواقعها داخل الدولة، لا بوصفها كفاءات وطنية، بل بوصفها “وكلاء ولاء” يسيطرون على قواعد اجتماعية عبر التجهيل والتبعية الدينية أو الزعامة المحلية.
بهذا المعنى، لم تسقط البنية الإقطاعية بل تحولت إلى شريك رسمي في “الجمهورية الحديثة”.
الديمقراطية كغطاء لتكريس التفاوت
ما حدث في موريتانيا منذ التسعينات لا يمكن وصفه إلا بـ الانتقال إلى التعددية الشكلية دون تغيير جوهر النظام.
صندوق الاقتراع لم يكن سوى وسيلة لإضفاء شرعية على نفس النخب، والدستور أصبح أداة لتجميل سلطة تتحكم فيها شبكات المصالح لا مؤسسات الدولة.
فالديمقراطية، بدل أن تكون آلية للمحاسبة والتداول، تحولت إلى واجهة رمزية لاحتكار السلطة والثروة.
إن مأزقنا اليوم ليس في غياب النصوص، بل في غياب الإرادة السياسية والأخلاق المدنية التي تجعل من النص مرجعية لا ديكورًا.
لقد ضاعت الدولة بين “مشروعية القبيلة” و”مشروعية الانتخاب”، وكلاهما يستخدم الآخر ليبرّر نفسه.
الشعب المنهك بين الفقر واليأس
أما الشعب، فقد استُنزفت قواه في معركة البقاء.
نسبة الفقر تتسع، والبطالة تطال فئات واسعة من الشباب، والتعليم ينتج أجيالًا محدودة الوعي عاجزة عن مساءلة السلطة أو ابتكار البدائل.
لقد تم تفريغ الطبقة الوسطى، التي تشكل عادة حاضنة الوعي والإصلاح، فتحول المجتمع إلى أطراف معزولة: أغنياء محميّون وفقراء مكسورون.
وفي غياب مشروع وطني جامع، أصبح المواطن يلوذ بقبيلته أو جهته أو شيخ زاويته، لا بوصفهم رموزًا اجتماعية، بل ملاذات اضطرار أمام دولة غائبة.
الهجرة، واليأس، والعزوف عن الشأن العام، ليست ظواهر اقتصادية فقط، بل دلائل على انكسار الثقة في إمكانية الإصلاح من الداخل.
وحين يختفي الأمل في التغيير السلمي، تُصبح كل احتمالات الانفجار واردة ولو بعد حين.
المآل: بين الإصلاح والانهيار البطيء
في ظل انسداد الأفق، وتآكل الثقة بين المواطن والنخبة، تبدو البلاد أمام خيارين أحلاهما مرّ:
إما أن تستمر دورة التدوير الفاسدة للنخب ذاتها، فينزلق المجتمع نحو تفكك بطيء للدولة؛
أو أن يتولد وعي جديد من الهامش، من داخل الفئات المهمشة والمثقفين المستقلين، يُعيد تعريف السياسة بوصفها التزامًا أخلاقيًا لا صفقة.
لكن التاريخ لا ينتظر المترددين. فإما أن يبدأ الإصلاح من الداخل قبل أن تفرضه الأزمات من الخارج، أو أن نجد أنفسنا أمام نموذج دولة مستنزفة لا تملك مقومات النهوض ولا أدوات الدفاع عن ذاتها.
الخاتمة: لا مفرّ إلا بالعودة إلى الذات
السؤال “أين المفر؟” ليس هروبًا من الواقع، بل بحثًا عن نقطة بدء جديدة.
لن يكون المفرّ في الانقلابات، ولا في تبديل الوجوه، بل في ثورة وعي حقيقية تعيد الاعتبار للقيم التي بُنيت عليها فكرة الدولة: المساواة، العدالة، الكفاءة، والمواطنة.
فالإصلاح لا يبدأ من قصر الحكم، بل من المدرسة، من الجامعة، من الإعلام، ومن الإرادة الجمعية في أن نكفّ عن تمجيد الولاءات الصغيرة على حساب الكيان الوطني.
إن المفرّ الحقيقي هو العودة إلى الذات الجمعية التي نسيها الجميع: أن نؤمن أن الدولة ليست إقطاعًا، ولا غنيمة، ولا صدقة، بل عقد أخلاقي بين الحاكم والمحكوم.
ومن دون هذا الوعي، ستبقى موريتانيا تدور في حلقة مفرغة من التجريب العقيم والخيبة المتكررة.
حمادي سيدي محمد آباتي