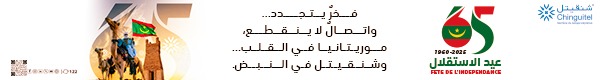من نيفادا إلى سياسة «عدم العودة إلى التفجير» — نهاية حقبة الاختبارات النووية الأميركية وإرثها
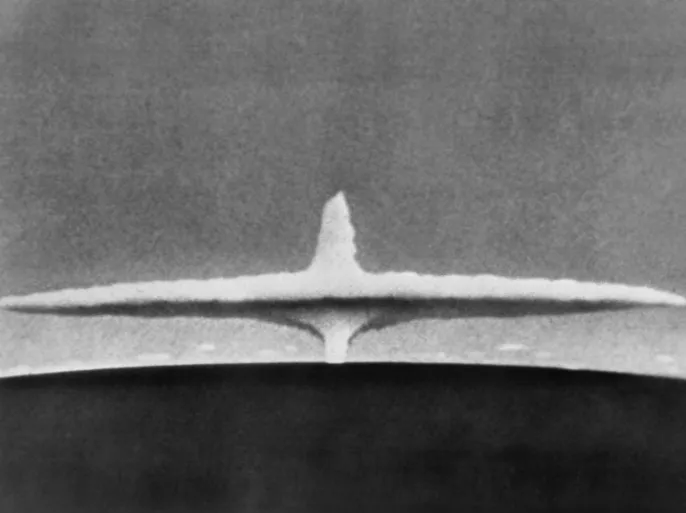
في 23 سبتمبر 1992، اختتمت صحراء نيفادا فصلاً طويلاً من التجارب النووية الأميركية باختبار حمل الاسم الرمزي «ديفايدر» (Divider)، وهو آخر تفجير نووي كامل الجسامة تُجريه الولايات المتحدة في القرن العشرين. جاء هذا الاختبار في لحظة تحول دولي حاسمة: انهيار الاتحاد السوفياتي وتلاشي حقبة الحرب الباردة، ما دفع إلى إعادة التفكير في جدوى واستمرارية التفجيرات الميدانية كأداة للردع أو العرض.
لم تعد أهداف الاختبارات آنذاك عرضًا للهَيْبة العسكرية كما في خمسينيات وستينيات القرن الماضي؛ بل اتجهت إلى فحوص محددة لمكونات فيزيائية داخل رؤوس نووية تكتيكية لضمان موثوقية الترسانة. وبعد أقل من أسبوعين من اختبار «ديفايدر» أعلن الرئيس جورج بوش الأب توقفًا مؤقتًا للتجارب، تحوّل لاحقًا إلى سياسة دائمة مع إدارة بيل كلينتون التي اختارت «عدم العودة إلى التفجير» وأطلقت عام 1995 برنامج «الحفاظ على الترسانة» (Stockpile Stewardship Program).
هذا التحوّل لم يكن مجرد قرار سياسي، بل نتيجة تراكم علمي: آلاف التجارب خلال عقود سمحت بجمع كمّ هائل من البيانات حول سلوك المواد الانشطارية، ما مكّن العلماء من تطوير نماذج حاسوبية متقدمة قادرة على محاكاة ديناميكيات الانفجار النووي دون الحاجة إلى تفجير فعلي. ومع دخول الألفية، صار الاعتماد على «التجارب دون الحرجة» (subcritical experiments) والمحاكاة الرقمية الركيزة الأساسية لفحص سلامة الرؤوس النووية.
في المقابل، استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في منشآت تقنية عالية تمكن من دراسة سلوك البلوتونيوم واليورانيوم تحت ظروف قريبة من الانفجار دون وصولها إلى الحالة الحرجة. مشاريع ومختبرات مثل مرافق بانتكس ومختبرات نيفادا الوطني للأمن النووي وأنظمة تصوير بالأشعة السينية عالية السرعة (مثل ما يُعرف بمشاريع مطورة لاختبارات الصدمات) صُمِّمت لرصد تغيّرات المادة الانشطارية في أجزاء من المليار من الثانية، ومتابعة آثار شيخوخة البلوتونيوم على الأداء.
نتيجة هذا المسار، طورت واشنطن أجيالًا جديدة من الأنظمة والرؤوس — من أمثلة ذلك برامج تحديث مثل B61-12 وB61-13 ومشروع W-93 — باستخدام أدوات المحاكاة والصيانة دون انفجار. كما أتاح تطور «هندسة العائد المتغيّر» إمكانية ضبط العائد التفجيري بحسب المهمة، ما أدى إلى ميل واضح نحو رؤوس أصغر وأكثر دقة وتنوعًا في الخيارات التشغيلية.
ومع ذلك، لا يسدل هذا النهج الستار على كل المخاوف: ثمة استثناءات فنية نادرة قد تتطلب اختبارًا حقيقيًا، خصوصًا عند إدخال مواد أو تصميمات جديدة لم تُختبر ميدانيًا من قبل. كما أن إعادة تشغيل بنية تحتية للاختبارات التفجيرية التي خُلِّفت منذ التسعينيات ستتطلب استثمارات ووقتًا كبيرين، ما يجعل القرار السياسي وحده غير كافٍ لإعادة دورة التجارب التقليدية.
على الصعيد السياسي والدبلوماسي، تحمل العودة إلى نقاشات التفجير كلفة كبيرة؛ فهي تؤثر على مصداقية واشنطن في ملفات نزع السلاح وتُعطي مبررًا لخصومها لتوسيع برامجهم، ما قد يعيد سباق التسلح إلى منعرجات ماضية. وفي الوقت نفسه، قد تُوظَّف لغة استئناف الاختبارات أحيانًا كأداة داخلية لاسترضاء قواعد سياسة معينة أو لتأكيد صورة القوّة، أكثر مما تستند إلى ضرورة فنية ملحّة.
في الختام، يظل السؤال المركزي قائماً: هل الوظيفة العلمية والعملية المضافة من استئناف التفجيرات النووية تبرّر تكاليفها السياسية والتقنية والإنسانية، أم أن منظومة المحاكاة والتجارب دون الحرجة الحالية كافية للحفاظ على موثوقية الترسانة وتأمين خيارات الردع في العصر الراهن؟