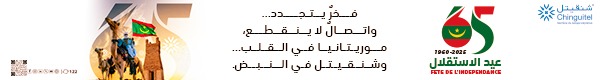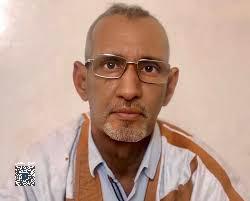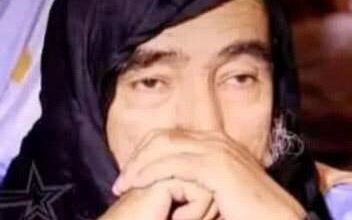ما السبيل إلى إنقاذ بلد مأزوم غارق؟

في بلد غني بالثروات وفقير حدّ الإذلال، تتجلى مفارقة تنوء بحملها الجبال. هذا الوطن، الذي حُبِي بأراضٍ شاسعة وثروات طبيعية متنوعة، يقف اليوم على حافة الانهيار، لا بسبب ضعف الإمكانات، بل بفعل فساد ممنهج وسوء إدارة متعمد، جعل من الشعب رهينة لفئة قليلة تنمو ببطء ولكن بثبات، تُحسن نهب المال العام وتُسيء تدبيره.
من خدم وزيرًا أو مديرًا أو ضابطًا ساميًا أو حتى شريكًا في منظومة التواطؤ، أصبح من أثرياء النهب، لا من بناة الأوطان. الأمثلة لا تُعدّ: ضيعات ريفية تم تمليكها كهبات خاصة، قُطعت إلى آلاف القطع تُباع بخمسين مليون للواحدة، رغم أنها لا تصلح للزراعة ولا للرعي، بفعل ملوحة الأرض. رخص صيد بيعت في السوق السوداء. صفقات مليارية تُمنح بناء على أوراق مزورة. مؤسسات تُنشأ على الورق فقط، لأجل تمرير صفقات تُنفذ بأرخص المواد، لتنهار فور انتهاء زيارة الفنيين.
خذ مثالاً: طريق الأمل، من ملتقى مدريد إلى توجنين، الذي رُصف بالصخور فُكك وأُعيد كصفقة باسم جديد. وهكذا، صفقات الطاقة، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية… كلها جراح تنزف.
احتكار السلطة وتدوير النفوذ داخل نفس الفئة
من أبرز معالم الأزمة الموريتانية اليوم، سيطرة فئة محدودة ومغلقة على مفاصل الدولة، تُعيد إنتاج نفسها جيلاً بعد جيل، في مشهد يفتقر إلى العدالة والكفاءة معًا. فهذه الفئة لا تكتفي بتصدر المشهد، بل تحتكره عبر تدوير المناصب بين أفرادها، مهما اختلفت الحكومات وتغيرت الشعارات.
يكاد يكون التقاعد بالنسبة لهم مجرد تغيير في العنوان؛ فبمجرد تقاعد أحدهم من منصب وزاري أو أمني، يُعيَّن فورًا رئيسًا لمجلس إدارة أو هيئة عمومية لا ضرورة لها. وفي الوقت ذاته، تجد أبناءه يتوزعون بين وزراء وأمناء عامين وسفراء، دون أن يكون الكفاءة أو الاستحقاق هو المعيار.
خذ مثالًا على ذلك: أسرة واحدة تجد منها سفيرًا، وموظفًا برتبة وزير، وقائدًا عسكريًا كبيرًا، وهم أشقاء، كما تجد الشيخ الهرِم مُعيَّنًا على رأس هيئة دينية أو ثقافية، بينما أبناؤه موظفون سامون، في وزارات حساسة ومجالس سيادية، رغم أن مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية كثيرًا ما تكون دون المستوى.
بل إن أبناء أعضاء حكومة الاستقلال، الذين أسّسوا مع المستعمر الشكلَ الأول للسلطة، لا زالوا يحتلون مناصب وزارية وأمنية وإدارية مرموقة إلى اليوم، وتوارثوا هذه الامتيازات كما تُورث العقارات. أما أبناء حكومة ما بعد الاستقلال، فقد ورثوا مناصب آبائهم كذلك، فترى الوالد رئيسًا لمجلس إدارة، أو رئيسًا لهيئة مثل “المجلس الاقتصادي والاجتماعي”، أو “المجلس الأعلى للفتوى والمظالم”، أو “وساطة الجمهورية”، في حين يتولى الابن حقيبة وزارية أو سفارة في الخارج.
هذه المجالس، على تعددها واختلاف مسمياتها، لا تُؤدي أي دور حقيقي في التنمية، بل أُنشئت فقط لتوفير وظائف عليا للمتقاعدين من النظام، ولمنحهم غطاء رسميًا للاستمرار في الاستفادة من المال العام بعد خروجهم من مناصب السلطة التنفيذية.
ووسط هذا الاحتكار، لا يبقى لبقية أبناء الشعب، خاصة الكفاءات الشابة والمستقلة، سوى هامش ضيق أو البطالة، مما يعمق الإحباط، ويغذي ثقافة الهجرة، والنفور من الشأن العام، بل وقد يدفع بعضهم إلى تبني أفكار احتجاجية أو حتى انفصالية، إذا استمر تغييبهم وإقصاؤهم.
العزلة الطبقية وتدمير التعليم
لكن الخطر الحقيقي لا يقتصر على الاقتصاد والسلطة، بل يمتد إلى البنية النفسية والاجتماعية. فالطبقة المخملية عزلت نفسها في زاوية من العاصمة، على أرض لا تصلح لشيء، فقط من أجل الانعزال. هناك شيّدوا قصورًا تتطلب صيانة سنوية باهظة، وأنشؤوا سبع مدارس خاصة تدرّس البرامج الفرنسية لأبناء الأسر الأرستقراطية محدودة العدد. ذلك لأنهم لم يعودوا قادرين على إرسال أبنائهم للدراسة في فرنسا أو المغرب، فاخترعوا التفافًا على القانون التوجيهي لإصلاح التعليم.
فكيف ننتظر إصلاحًا تعليميا في ظل هذه المعاول؟ معاول توسيع الخريطة المدرسية دون دراسة، وتوظيف متعاقدين بلا كفاءة ولا تكوين، والمناهج المتهالكة التي لا تراعي حاجات السوق ولا الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تدريس العلوم بلغة أجنبية غير مفهومة. المربون أنفسهم أثبتوا أن العبقري حين يدرس بلغة أجنبية لا يستفيد أكثر من 60%، بينما يمكن أن تصل استفادته إلى 80% لو درس بلغته الأم.
المجتمع المخنوق وإرادة التغيير المقموعة
وفي هذا المناخ، يختنق الوعي وتتآكل الإرادات. فثقافة الخوف والطمع التي رُوّج لها باعتبارها “من خصائص العلاقة بالحكومة”، حوّلت النخب إلى منافقين، وأعطت للأنظمة القدرة على التحكم في الحشود متى أرادت، عبر مسرحيات انتخابية أو زيارات رسمية، تُستنهض لها الأصوات المجمدة، ليصوّت الناس تحت ضغط الفقر أو التهديد أو التزوير.
أما الأصوات الحرة، فمُكبّلة بقيود التهميش، والإقصاء، واليأس. فلا صوت يُسمع، ولا إصلاح يُطبق، ولا تغيير يُقبل، إلا بإذن من نفس الحلقة التي دمرت البلد.
الطريق إلى الإنقاذ
- الاعتراف بأن الدولة تُدار بمنطق الغنيمة، وهذا يتطلب إرادة سياسية صادقة لكسر هذا المنطق. لا يُمكن إصلاح بلد تُمنح فيه صفقات التسيير لمن زوّروا عقود إيجار، ولا تُحاسب فيه من باعوا أراضي الشعب بأثمان فلكية.
- إعادة بناء العقد الاجتماعي، على أساس المواطنة، لا الانتماء القبلي أو الطبقي أو الجهوي. فبدون عدالة اجتماعية، لن يكون هناك استقرار دائم.
- تحرير التعليم من قبضة المافيا الطبقية، عبر ضبط المدارس الخاصة، وربط البرامج التعليمية بحاجات الاقتصاد، وتدريس العلوم باللغة الأم، وتعزيز التكوين المستمر للمعلمين.
- فتح ملفات الفساد دون انتقائية، بما فيها ملفات العقارات، والرخص، والصفقات، ومحاكمة المتورطين علنًا.
- استنهاض النخبة وتحريرها من ثقافة النفاق، عبر تهيئة بيئة آمنة للرأي الحر، وتشجيع التفكير النقدي، واستقلال الإعلام الحقيقي.
- منع تكرار إعادة إنتاج نفس النظام برؤوس جديدة، فالتدوير الإداري والسياسي لا يصنع تنمية، بل يُعمق الجمود.
- مراقبة الطبقة العسكرية ومساءلتها، لا سيما أن تجارب كثيرة أظهرت أن الحكم العسكري غالبًا ما يجنح للهيمنة بدل التنمية.
- إشراك الشباب، فهم أصحاب المصلحة الفعلية في مستقبل البلاد. دون إشراكهم، ستظل الدولة تدور في فلك أجيال نهبتها وأفقرتها.
إذا لم تُتخذ خطوات جذرية وعاجلة، فقد لا نكون أمام مجرد أزمة فساد أو تعليم، بل أمام سيناريو انهيار تام، قد يتخذ طابعًا صراعيا، يفتح الباب لتدخل قوى أجنبية لطالما حلمت بتقسيم البلد: جزء يُلحق بجنوب غرب الجوار، وآخر يُستدرج نحو حرب بين طامعين؛ أحدهم دعمنا تاريخيًا، والآخر لم يعترف يومًا بحدودنا ولا بهويتنا.
فهل ننتظر المعجزة، أم نبدأ من الآن؟
حمادي سيدي محمد آباتي