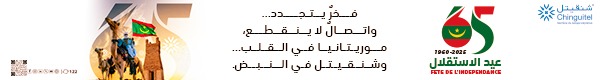حين يختلّ الميزان: التهذيب والتربية والتعليم بين ضياع المفاهيم وتنازع الأدوار

لم تعد أزمة التعليم في مجتمعاتنا المعاصرة أزمة مناهج أو نقص معارف بقدر ما هي أزمة تصوّر واختلال أدوار. فقد جرى – خلال العقود الأخيرة – اختزال العملية التربوية في بعدها الأكاديمي الضيق، حتى غدا التعليم مرادفًا للتحصيل والدرجات، وتوارى خلف ذلك جوهر التربية القائم على بناء الإنسان أخلاقيًا وقيميًا وسلوكيًا.
هذا الاختزال لم يكن بريئًا ولا عابرًا، بل خلّف آثارًا عميقة تجلّت في سلوك المتعلمين، وفي طبيعة العلاقة بين الطالب والمعلّم، وبين المدرسة والأسرة، بل وفي نظرة المجتمع نفسها إلى وظيفة التعليم.
أولًا: الخلط بين المفاهيم… أصل الداء
من أبرز مظاهر الخلل السائد اليوم الخلط بين التهذيب والتربية والتعليم، وكأنها مفاهيم مترادفة، بينما هي في حقيقتها دوائر متمايزة متكاملة:
التهذيب هو السلوك الظاهر: الأدب، الاحترام، الانضباط، طريقة الخطاب، وتقدير الآخر، وخاصة المعلّم. وهو يُكتسب بالممارسة اليومية والقدوة قبل التلقين.
التربية هي البناء الداخلي للإنسان: منظومة القيم، والضمير، والمسؤولية، ومعنى الخير والشر، والانتماء الأخلاقي والديني.
التعليم هو نقل المعرفة والمهارات والكفاءات العقلية والمنهجية.
وحين يُختزل التعليم في نقل المعرفة فقط، دون تهذيب يضبط السلوك، ولا تربية تؤسس القيم، فإن النتيجة الحتمية هي متعلّمٌ يحمل شهادة، لكنه يفتقر إلى البوصلة الأخلاقية.
ثانيًا: الأسرة… المسؤولية التي لا تُعوَّض
الأسرة هي الحاضنة الأولى للتهذيب والتربية، وأي تقصير فيها لا تستطيع المدرسة تعويضه بالكامل. فالطفل الذي لا يتعلم في بيته احترام الوالدين، لا يُنتظر منه أن يحترم المعلّم. والخطر الأكبر حين يبلغ الإهمال حدّ تزيين احتقار المعلّم بدعوى الرجولة أو الجرأة، وهو في حقيقته تدريب مبكر على الوقاحة، ستدفع الأسرة نفسها ثمنه لاحقًا.
لقد انشغلت كثير من الأسر بالشهادة ونتائج الامتحانات، وتخلّت – عن وعي أو غير وعي – عن دورها التربوي، ظنًا منها أن المدرسة تقوم مقامها، وهو وهمٌ تربوي خطير.
ثالثًا: المدرسة… شريك لا بديل
المدرسة ليست مصنع شهادات، بل فضاء للتنشئة الاجتماعية والقيمية. غير أن السياسات التعليمية الحديثة دفعتها – في كثير من الأحيان – إلى الفصل بين التعليم والتربية، والاكتفاء بالمنهج والاختبار، مع ضعف العلاقة بالأسرة والمحيط الاجتماعي.
والمدرسة، بحكم طبيعتها، مفتوحة على المجتمع ومفتوحة له، ولا يمكن أن تنجح رسالتها دون شراكة حقيقية مع الأسرة، قائمة على التواصل، والتكامل، وتوحيد الرؤية حول بناء المتعلم.
رابعًا: مكانة المعلّم… بين الرمز والواقع
إن تراجع احترام الطالب لمعلّمه ليس حادثة فردية، بل مؤشر على خلل تربوي عميق. وقصة هارون الرشيد مع الأصمعي – وإن كانت تحتاج إلى تنزيلٍ واعٍ على واقعنا – فإن مقصدها واضح: تعظيم العلم بتعظيم حَمَلته، لا إذلال المتعلم، ولا تقديس الأشخاص، بل ترسيخ قيمة الاعتراف بالفضل ومكانة المعرفة.
فالمدرسة التي يُكسر فيها المعلم رمزيًا، لا يمكن أن تبني متعلمًا سويًا.
خاتمة
إن إصلاح التعليم لا يتحقق بتراكم المعلومات، ولا بتغيير المناهج وحدها، بل بإعادة التوازن بين التهذيب والتربية والتعليم، وتحديد المسؤوليات بوضوح:
أسرة تُهذّب وتُربي،
ومدرسة تُعلّم وتُكمّل التربية،
ومجتمع يدعم القيم ولا يهدمها.
حينها فقط يمكن أن نستعيد المعنى الإنساني للتعليم، ونؤسس لإصلاحٍ تربويٍّ مستدام، لا يُنتج متعلّمين ناجحين فحسب، بل إنسانًا متكاملًا علمًا وقيمًا وسلوكًا.
حمادي سيدي آباتي