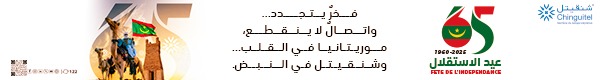حين تُثقِل الذاكرة الفردية بما عجز عنه المجال العام

في موريتانيا، لا يتشكّل الإرهاق الفردي بمعزل عن التاريخ، ولا تُفهم الذاكرة بوصفها شأنًا شخصيًا صرفًا. ما نحمله في الداخل هو، في كثير من الأحيان، تراكمُ ما لم يُحسَم جماعيًا، وما لم يُقل في الوقت المناسب، وما جرى تأجيله باسم السلم الاجتماعي، أو الاستقرار، أو “تفادي الفتنة”.
نحن أبناء مجتمعٍ تعلّم مبكرًا كيف يعيش على التحمّل.
تحمّل الفقر بوصفه قدرًا، والتفاوت بوصفه واقعًا، والتهميش بوصفه أمرًا عاديًا، والصمت بوصفه حكمة. في هذا السياق، لم تكن الذاكرة مساحة استدعاء حرّ، بل مستودعًا لما لا يُسمح له أن يظهر في العلن.
كثيرٌ من الموريتانيين لا يحملون ذكرياتهم في الوعي فقط، بل في أجسادهم.
تعبٌ مزمن لا يجد تفسيرًا طبيًا، توتّر دائم، إحساس ثقيل باللاجدوى، وكأن الجسد يُعبّر عمّا لم يستطع المجال العام استيعابه. فحين تُغلق قنوات التعبير، تتحوّل التجربة إلى عبء داخلي، لا إلى خطاب.
في مجتمعٍ تُدار فيه الخلافات الكبرى بالتأجيل، وتُحلّ أزماتُه بالصمت المؤقّت، تتراكم الذاكرة الفردية كما تتراكم الملفات غير المفتوحة. لا لأن الناس لا تشعر، بل لأن الشعور بلا لغة، والذاكرة بلا اعتراف، والوجع بلا أفق سياسي أو اجتماعي.
الهشاشة الاقتصادية، والتراتبية الاجتماعية الصارمة، وتاريخ الإقصاء غير المُسمّى، كلها عوامل تُنتج فردًا متيقّظًا أكثر مما ينبغي. فردًا يتعلّم باكرًا أن يزن كلماته، وأن يضبط مشاعره، وأن يُخفي اعتراضه، ليس نفاقًا، بل حفاظًا على الحدّ الأدنى من الأمان.
وهنا، لا يكون الإرهاق نتيجة فشل شخصي، بل أثرًا جانبيًا للعيش داخل بنية تطلب من الفرد أن يتكيّف أكثر مما تطلب من نفسها أن تتغيّر.
الذاكرة في السياق الموريتاني ليست فقط ما عشناه، بل ما ورثناه أيضًا.
ذاكرة جماعية مثقلة بتاريخ لم يُفكَّك بعد، وبسرديات متجاورة لم تُصالح، وبأسئلة هوية تُدار بحذر شديد، خوفًا من فتح جراح قديمة. وكل ما لا يُفكَّك جماعيًا، يُدفع الأفراد إلى حمله كلٌّ بطريقته.
لهذا، نرى أفرادًا يُجيدون الاستمرار، لكنهم يفتقدون الإحساس بالاتجاه.
يؤدّون أدوارهم الاجتماعية بإتقان، لكنهم يشعرون بثقل داخلي لا يزول. لأنهم لا يعيشون حاضرهم فقط، بل يعيشون معه تاريخًا لم يُغلق، ومجتمعًا لم يمنحهم بعد حقّ التعبير الكامل.
في هذا السياق، يصبح الجسد أرشيفًا بديلًا.
ما لم يُعترف به سياسيًا أو اجتماعيًا، يُسجَّل بيولوجيًا: قلق، أرق، أمراض ضغط، إنها لغة صامتة لواقع لم يجد قنواته الطبيعية.
التحرّر من هذا الإرهاق لا يمرّ عبر وصفات نفسية جاهزة، ولا عبر دعوات فردية للتكيّف الإيجابي، بل عبر إعادة فتح الأسئلة المؤجَّلة. ليس بهدف الصدام، بل بهدف التفكيك: تفكيك الصمت، وتفكيك خطاب التحمّل، وتفكيك الوهم القائل إن الاستقرار يُبنى على الكبت.
حين نُعيد للذاكرة حقّها في الاعتراف، لا نهدّد السلم الاجتماعي، بل نمنحه أساسًا أكثر صلابة. فالمجتمع الذي يسمح لأفراده أن يُعبّروا، أقلّ كلفة من مجتمع يُجبرهم على أن يحملوا كل شيء في الداخل.
الذاكرة، حين تُترك بلا معالجة، تُرهق الأرواح وتُثقِل الأجساد.
لكنها، حين تُفهم في سياقها، تتحوّل من عبءٍ صامت إلى سؤالٍ عامّ:
ما الذي يجب أن نُعالجه جماعيًا، حتى لا نواصل استنزاف الأفراد فردًا فردًا؟
ذلك هو الفرق بين مجتمع يُدير أزماته بالتأجيل، ومجتمع يملك شجاعة الإصغاء… قبل أن يتحوّل الإرهاق إلى قدرٍ جماعي.
حمادي سيدي محمد آباتي