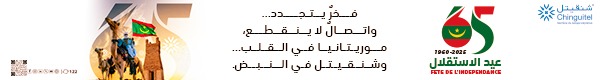حين تتحوّل رسالة الإصلاح إلى أداة للهيمنة

من يتأمل مسيرة النخب الحاكمة في موريتانيا، لا بد أن يستدعي حادثة الفلاح المصري الفقير الذي اعترض موكب محمد علي باشا بالشتائم، لا على شخصه فحسب، بل على وزرائه وجنده. كانت ردة فعل الجنود متوقعة: همّوا بقتله، لولا أن الباشا أوقفهم، واصطحب الرجل إلى قصره، أسكنه جناحاً خاصاً، وأطعمه مما يأكل، وكساه مما يلبس.
ومرت سنة أو تزيد، حتى أمر محمد علي بإحضاره. قال له: “الآن سأقتلك.”
وحين استجدى الرجل عفوه، أجابه الباشا: “أعلم أنك شتمتني وأنت مستعد للموت، لأنك سئمت حياة البؤس.
أما الآن، وقد عرفت لذة العيش، فلن أتركك تعود لما كنت عليه، وسأمنعك من مجابهتي.”
هذا المشهد الرمزي لا يمكن فصله عن أسلوب تعامل الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا مع أصوات الممانعة ومحاولات الإصلاح. فالمصلحون ـ حين لا يُقمعون ـ يُستوعبون داخل دوائر السلطة، ويُغدق عليهم من الامتيازات ما يكفي لإسكاتهم.
غير أن الفارق الجوهري بين مدرسة محمد علي القديمة والمدرسة “الموريتانية” الجديدة يكمن في أن أبناء الفقراء الذين تم تدجينهم لم يعودوا عرضةً للقتل، بل أصبحوا شركاء في تعميق المأساة، وفاعلين في مشروع الظلم ذاته الذي كانوا ضحيته.
لقد استوعبت الأنظمة الحاكمة كل من تجرأ على فضح مظالمها، فغمرته بالامتيازات، ثم تركت أقرباءه وأمته يغرقون في الجهل والحرمان.
وهكذا، بدل أن يصبح الإصلاحي منارة للوعي، تحول إلى أداة لتكريس التخلف والسكوت.
وما يفاقم من عمق المأساة هو غياب الوعي الجمعي بسبب تآمر الأنظمة على التعليم، وتهميش المثقفين، ومطاردة كل من يحاول كسر دائرة التجهيل.
فقد عمدت النخب الحاكمة إلى تجفيف ينابيع الوعي وتفكيك مؤسسات التكوين والتربية، حتى بات من النادر أن ترى مشروعًا فكريًا أو ثقافيًا يتجاوز الزخرف الشكلي إلى طرح جوهري.
روح مدرسة محمد علي باشا ـ أي استبدال القتل بالرفاه كوسيلة لإخراس الأصوات المعارضة ـ تتجسد اليوم في سياسات تدجين النخب، خاصة على مستوى سكان الضفة، حيث جرى التعامل معهم بسياسات ناعمة مبنية على تبادل المنافع في أغلب الأحايين ، وتركهم يكسبون المال والامتيازات ليستمرئوا الراحة، ويفقدوا شهية الاحتجاج.
ورغم قسوة هذا الواقع، فإن الأمل لا يموت.
ردة فعل المظلومين قد تتأخر، لكنها حتمية.
والتاريخ يعلمنا أن الظلم إذا اشتد، والوعي إذا انبعث، فإن الفعل سيكون في مستوى التحدي.
حينها لا ينفع الندم، ولا يجدي التحايل.
إن موريتانيا لم تعرف حكما مركزياً قبل الاستعمار الفرنسي.
وذاك الاستعمار لم يؤسس دولة لصالح الشعب، بل سلّم مفاتيحها لطبقة وظيفية همها جمع الضرائب وتدجين المجتمع.
أبناء هؤلاء، هم من يتولون اليوم إدارة الشأن العام، ولا ينتظر منهم أن يضيئوا الطريق لرعية قد تطالبهم بالحساب.
وهكذا، نظل بين الرجاء واليأس، بين وعود الإصلاح ومشاريع الخديعة.
فهل ننتظر ردة الفعل، أم نعمل على توعيتها قبل أن يأتي الانفجار؟
حمادي سيدي محمد آباتي