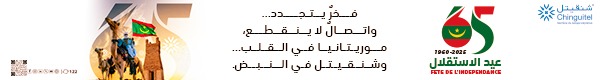الوحدة الوطنية في موريتانيا بين إدارة التنوع وصناعة الهشاشة: قراءة سوسيولوجية سننية

لا تُهدَّد الدول بتعدديتها، بل تُهدَّد حين تفشل في إدارة هذه التعددية ضمن إطار جامع يحفظ المعنى المشترك للانتماء. وفي هذا السياق، تبدو موريتانيا اليوم أمام لحظة دقيقة تستدعي قراءة سننية عميقة لمسار الدولة والمجتمع، بعيدًا عن الانفعالات الظرفية أو المقاربات الاختزالية.
فالتنوع الإثني والثقافي في موريتانيا معطى تاريخي طبيعي، غير أن تحويله إلى موضوع صراع رمزي، أو توظيفه سياسيًا خارج منطق العدل والتوافق، يفتح الباب أمام هشاشة بنيوية قد لا تظهر آثارها فورًا، لكنها تتراكم بصمت حتى تبلغ لحظة الانفجار.
أولًا: اللغة الجامعة كشرط تماسك حضاري
ليست اللغة في التجربة الموريتانية مسألة تواصل فقط، بل عنصر تأسيسي في بناء المجال العمومي المشترك. فاللغة العربية، قبل الاستعمار بقرون، لم تكن لغة فئة أو إثنية بعينها، بل كانت:
لغة الأدب والشعر،
ولغة القضاء والفتوى،
ولغة الدين الواحد الذي جمع الجميع،
ولغة التداول العلمي والمعرفي في المحاظر.
لقد شكّلت العربية الوعاء الرمزي الذي التقت فيه المكوّنات الاجتماعية كافة، دون أن تلغي خصوصياتها الثقافية المحلية. أما اللهجات المحلية، فقد ظلت – تاريخيًا – أدوات تواصل داخلي داخل كل مجموعة، ولم تتحول يومًا إلى لغات دولة أو مؤسسات، ولا إلى حامل حضاري جامع.
من هنا، فإن الدعوات إلى ترسيم لهجات محلية، أو مساواتها باللغة العربية في المجال السيادي، لا يمكن قراءتها بوصفها مطالب ثقافية بريئة فقط، بل ينبغي فحصها ضمن آثارها السننية بعيدة المدى على وحدة الوعي الوطني.
ثانيًا: بين لغة الاستعمار ولهجات التفكيك
إن أخطر ما قد تواجهه الدولة هو استبدال اللغة الجامعة بلغة المستعمر من جهة، أو بتفكيك المجال الرمزي عبر ترسيم لهجات جزئية من جهة أخرى. فكلا المسارين، وإن اختلفا في الظاهر، يلتقيان في نتيجة واحدة: تفكيك المشترك الوطني.
فاللغة الاستعمارية لا تحمل ذاكرة المجتمع ولا قيمه، واللهجات المحلية – مهما كانت عزيزة على أهلها – لا تملك الشروط التاريخية ولا الوظيفية لتكون لغة دولة جامعة. وعندما يُفتَح المجال العمومي أمام هذا التنازع الرمزي، يصبح الانقسام مسألة وقت لا أكثر.
ثالثًا: تقييد الحريات وتسريع المسار الانقسامي
في منطق السنن الاجتماعية، لا تُدار المجتمعات بالقمع، بل بالعدل والحوار. إن الاتجاه نحو تقييد الحريات، أو تضييق مجال التعبير باسم حماية الرموز أو الاستقرار، يحمل خطرًا مضاعفًا؛ إذ يحوّل النقاش المشروع إلى احتقان صامت، ويُراكم شعور الإقصاء بدل معالجته.
فحين تُغلَق قنوات الحوار العلني:
يتراجع النقاش العقلاني،
وتتصاعد الخطابات الهوياتية المغلقة،
ويتحوّل الاختلاف الطبيعي إلى انقسام نفسي ورمزي.
رابعًا: الحوار الوطني المنظَّم كضرورة سننية
إن مواجهة هذه المخاطر لا تكون بإجراءات فوقية أو قوانين زجرية، بل بإطلاق حوار وطني جامع، منظم، وصريح، يُدار بمنطق الشراكة والمسؤولية التاريخية. حوار يعترف بالتنوع الثقافي بوصفه رصيدًا، لكنه يُثبّت في الوقت ذاته:
مركزية اللغة العربية كلغة جامعة للدولة والمجال العمومي،
وحدة المرجعية الرمزية للأمة،
وحق الجميع في التعبير ضمن سقف الهوية الوطنية المشتركة.
فالحوار، هنا، ليس تنازلًا سياسيًا، بل ممارسة سيادية واعية، تُغلق مسارات التفكك قبل أن تتحول إلى وقائع يصعب تداركها.
خامسًا: إدارة الاختلاف بدل تحويله إلى صراع
إن المجتمعات الحيّة لا تُنكر اختلافاتها، لكنها تضعها في ميزان التكامل لا التنازع. فالتنوع الثقافي ضرورة حيوية لتحقيق التوازن الاجتماعي، تمامًا كما يُعدّ التنوع البيئي شرطًا للتوازن الإيكولوجي. غير أن هذا التنوع، حين يُفصل عن إطار جامع، يتحول من مصدر غنى إلى أداة هدم.
خاتمة
إن موريتانيا، بتاريخها وروابطها الحضارية، تملك من عناصر الوحدة أكثر مما تملك من أسباب الانقسام. غير أن السنن لا تحمي أحدًا تلقائيًا؛ فالوحدة تُصان بالعدل، والحريات المسؤولة، والحوار، وبالتمسك باللغة العربية بوصفها الوعاء المشترك الذي صاغ الوجدان الجمعي قبل الاستعمار وبعده.
فحين تُدار الاختلافات بحكمة، تبقى الدولة إطارًا جامعًا، وحين يُهمل المشترك الرمزي، يصبح التفكك احتمالًا مفتوحًا. والاختيار، في النهاية، ليس قدريًا، بل سياسيًا-حضاريًا بامتياز.
حمادي سيدي محمد آباتي