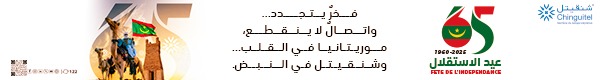الضرائب في الميزان: بين منطق الدولة وقلق المواطن

تؤكد المعطيات الرسمية أن نسبة الضرائب المباشرة على المواطنين انخفضت من 61% إلى 42% من مجموع المحاصيل الضريبية خلال السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع مساهمة الشركات إلى 58%. كما تشير إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأساسية كالقمح والزيوت والسكر، مقابل رفعها على ما يُصنف ضمن الكماليات كالمشروبات والسجائر والمكيفات والهواتف.
من الناحية النظرية، يبدو هذا التوجه منسجمًا مع مبدأ العدالة الجبائية: تخفيف العبء عن الأساسيات، وتحميل الكماليات نصيبًا أكبر. لكن الواقع المعيش يكشف تعقيدات لا تختصرها الجداول المالية.
الهاتف اليوم لم يعد ترفًا خالصًا. هو أداة عمل، ووسيلة تحويل أموال، ومنصة تعليم وتواصل مهني. رفع الجمركة عليه بنسبة 30% قد يُقرأ ماليًا كضريبة على سلعة، لكنه اجتماعيًا قد يُفهم كزيادة على وسيلة إنتاج ورزق.
أما الضرائب المفروضة على التحويلات الإلكترونية، فهي تمس شبكة واسعة من صغار الفاعلين: نقاط تحويل، تجار صغار، وأسر تعتمد على التحويلات اليومية. في اقتصاد يغلب عليه النشاط غير المهيكل، أي ضريبة جديدة قد يكون أثرها أكبر على الفئات الهشة.
يبقى السؤال الأهم: أين يلمس المواطن أثر هذه الضرائب؟
حين يضطر المريض للسفر للعلاج خارج البلاد، وحين يسعى ولي الأمر لإرسال ابنه للدراسة في الخارج، وحين يواجه المستثمر الصغير صعوبات إجرائية، فإن النقاش لا يعود متعلقًا بنسبة 16% أو 18%، بل بجودة الإنفاق العام وفعاليته.
الدولة بحاجة إلى موارد، ولا يمكن أن تقوم بلا جباية. لكن الشرعية الضريبية لا تُبنى على الحاجة وحدها، بل على الثقة. والثقة تُبنى حين يرى المواطن أن كل أوقية تُجبى تعود عليه خدمةً ملموسة.
الاعتراض على بعض الضرائب لا يعني رفض مبدأ الدولة، بل هو تعبير عن قلق مشروع: هل تتوسع الجباية بنفس سرعة تحسن الخدمات؟ وهل يترافق ارتفاع التحصيل مع إصلاحات حقيقية في التعليم والصحة والبنية التحتية؟
في نهاية المطاف، تنجح السياسة الضريبية حين يشعر المواطن أنه شريك في عقد عادل، لا ممولًا بلا مقابل واضح. فالأرقام قد تُقنع الخبراء، لكن الواقع هو الذي يقنع الناس.
حمادي سيدي.محمد أباتي