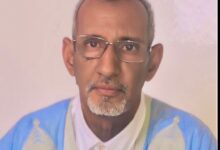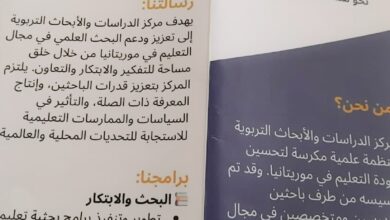السرديات التاريخية والوثائق الأصلية: درعٌ للحفاظ على الإرث المقدسي

شكّلت السرديات التاريخية والوثائق الأصلية -كالبرديات، والنقوش، والنقود، والأوامر الديوانية– ركيزة أساسية في حماية الإرث الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المتنوع لمدينة القدس المحتلة، في مواجهة محاولات الطمس والتحريف.
وفي هذا الإطار، نشرت اللجنة الملكية لشؤون القدس في عمّان دراسة متخصصة بعنوان “الروايات والوثائق التاريخية ودورها في حفظ الموروث المقدسي”، أعدّتها الدكتورة غيداء عادل خزنة كاتبي، أستاذة التاريخ والفكر الاقتصادي والدراسات الحضارية في الجامعة الأردنية، وأحد أبرز الأكاديميين في هذا الحقل البحثي. وتُعدّ هذه الدراسة من أوفى الأعمال العلمية التي تناولت موضوع الموروث المقدسي بالتحليل والتوثيق.
وفي تقديمه للدراسة (الصادرة عام 2020)، يؤكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، الدكتور عبد الله توفيق كنعان، أن الوعي بالتاريخ ليس ترفًا ثقافيًا، بل “ضرورة حضارية” تضمن استمرارية الهوية وحمايتها، وتمثل أساسًا في مسيرة بناء الأمة وتعزيز مقومات نهوضها.
ويرى كنعان أن هذا العمل البحثي يندرج ضمن الجهد الواجب لدعم صمود الفلسطينيين، وترسيخ حقوقهم المشروعة في القدس وفلسطين، خاصة في ظل ما تتعرض له الهوية الفلسطينية من محاولات طمسٍ وتزييف على يد الاحتلال الإسرائيلي الذي يروّج لرواية تاريخية قائمة على الأساطير والتأويلات المضلّلة.
موروث اجتماعي متنوع وتاريخ من التسامح
تُظهر الدراسة أن الحياة الاجتماعية في القدس خلال العصور الإسلامية تميزت بالتنوع الثقافي والانفتاح، حيث كانت المدينة مقصدًا للعلماء والتجار، ومركزًا لتلاقي الحضارات والمعارف. وقد انعكس هذا التنوع على غنى العادات والتقاليد التي تطورت فيها عبر القرون.
وتوثّق الكاتبة عبر عدد من البرديات والأوامر السلطانية حالة التسامح الديني التي شكّلت إحدى ركائز المجتمع المقدسي، والتي تعود جذورها إلى “العهدة العمرية”. فقد نصّ مرسوم مملوكي صادر عام 1458م على السماح لبطرك النصارى الملكيين، مرقص بن علم، بالتنقل بحرية بين مصر والقدس وسائر بلاد الشام، “وفقًا للعادات القديمة”، في إشارة إلى استمرار سياسات التسامح والتعاون.
كما تظهر وثيقة أخرى أن الرهبان المسيحيين لم يكونوا يُجبرون على دفع ضرائب أو خفارات أثناء دخولهم القدس، ما يعكس احترام الدولة الإسلامية لخصوصية الطوائف الدينية الأخرى، بل وتوفير نفقات دائمة لدعم المدينة وتعزيز أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
القدس ومكانتها الروحية
تبيّن الدراسة أن زيارة القدس كانت تشكّل بعدًا روحانيًا عاليًا، لا سيما لدى من تعذّر عليهم أداء فريضة الحج. وتستشهد الكاتبة برواية عن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، الذي زار بيت المقدس عدة مرات، ما يؤكد المكانة الدينية الخاصة للمدينة في الوعي الإسلامي.
وتُبرز الوثائق الوقفية –كوثيقة عام 1346م– الدور الحيوي الذي لعبه المغاربة في دعم المؤسسات الاجتماعية في القدس من خلال الأوقاف، بما أسهم في نهضة المدينة واستقرارها. وتوضح الوثيقة أيضًا احترام الحضارة الإسلامية للإرث التاريخي السابق، إذ تُسجّل حماية “القبو الروماني” كمثال على التفاعل مع الحضارات السابقة، في تناقض صارخ مع سياسات الاحتلال القائمة على الطمس والتخريب.
دور المقدسيين في نشر العلم والثقافة
تلقي الدراسة الضوء على مساهمة المقدسيين في إثراء الحياة الثقافية في العالم الإسلامي، ومن أبرز الشواهد على ذلك تأسيس “المدرسة العمرية” في حي الصالحية بدمشق عام 1156، بعد أن اضطر كثير من سكان القدس إلى النزوح بسبب الحروب. وقد سُمّيت المدرسة باسم الشيخ أبي عمر المقدسي، ما يعكس الامتداد الثقافي والتعليمي لسكان المدينة خارج حدودها.
إرث ثقافي ومعرفي راسخ
عرفت القدس منذ العصور الإسلامية بأنها مركز علمي وثقافي بارز، احتضن المؤسسات العلمية والمكتبات العامة، وخرّج أعلامًا تركوا بصماتهم في مدن الخلافة الكبرى. ويشير عدد من النقوش الأثرية إلى تخصيص موارد مالية لتعليم الأيتام والفقراء، ومنها نقش يعود إلى عام 1198م ينصّ على تخصيص بيت وأجرة للمعلمين مقابل تدريس المساكين.
كما توثق الدراسة اهتمام الدولة الإسلامية بتنظيم الشؤون الدينية والتعليمية في المسجد الأقصى، حيث يبرز مرسوم سلطاني صدر عام 1386م، يحدد أوقات التدريس والخطب داخل قبة الصخرة، ويشمل دروسًا في التفسير والحديث والمواعظ.
ازدهار اقتصادي وإنتاج محلي متنوع
تُظهر المؤلفات الجغرافية والوثائق البردية أن القدس كانت من أكثر مناطق فلسطين خصوبة، واشتهرت بزراعة الزيتون والعنب والتين والقمح. كما برع أهلها في تخزين المحاصيل بأساليب متقدمة، مثل استخدام الآبار لتخزين الزيت، والقلاع لحفظ الحنطة، ما يعكس وعيًا مبكرًا بالأمن الغذائي.
وتكشف الوثائق عن رعاية دائمة لمرافق المسجد الأقصى، وتوفير فرص عمل في مجالات العمارة والصيانة. أما التجارة، فقد عرفت رواجًا مبكرًا، ويشير الأسقف “أركوف” خلال زيارته للقدس في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان إلى سوق سنوي نشط يفد إليه التجار من مختلف الأقاليم.
كما ازدهرت صناعة النسيج، واشتهرت المنتجات المعروفة باسم “المقدسي”، من منسوجات قطنية وسجاد صلاة وبطانيات يدوية.
إرث حضاري محفوظ باليد والعقل
حرص العلماء والمثقفون في القدس على نسخ الكتب وتوريثها لأبنائهم، وظهر من بينهم من امتهن “نسخ الكتب بالأجرة”، وهو ما يدل على حيوية المشهد الثقافي، وأهمية التأليف والنقل المعرفي في صون الإرث العلمي والحضاري للمدينة.
توصيات الدراسة
اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
- إدراج مادة القدس كمقرر إلزامي في الجامعات الأردنية والعربية والإسلامية، لتعزيز الوعي بالهوية المقدسية.
- تنظيم فعاليات علمية تتناول التراث المقدسي لا من الناحية الأكاديمية فقط، بل من خلال استعراض العادات، والفلكلور، والتاريخ الشفوي.
- إطلاق مبادرات حضارية تهدف إلى إحياء الموروث المقدسي، وترسيخ رسالة ثقافية عالمية مفادها أن للقدس هوية حضارية متجذّرة لا يمكن طمسها.